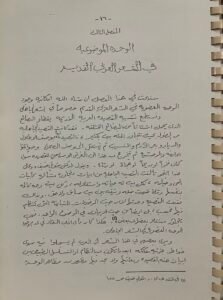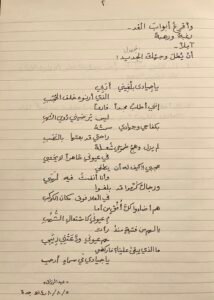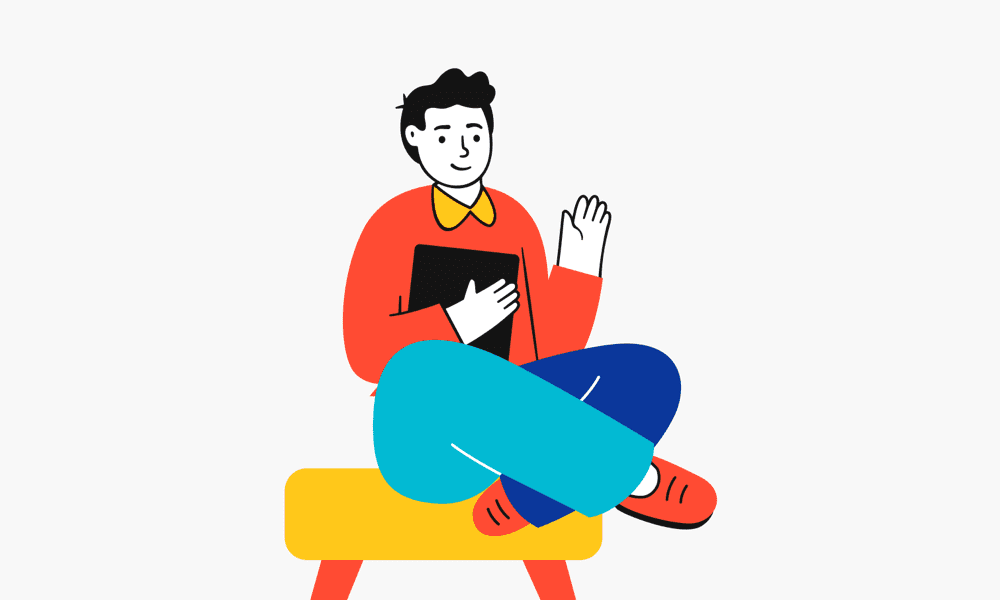رواية من سائق قلّاب إلى.. أكاديمي!
نقلناها لكم على لسان صاحبها، الأستاذ الدكتور/ عبدالرزاق الصاعدي

من سائق قلّاب إلى.. أكاديمي!
من سن الـ 17 إلى 24 من عمري كنت أعمل في القلّاب من بعد صلاة الفجر إلى أذان العصر، ستة أيام في الأسبوع، 12 شهرًا في السنة.. وفي الـ 26 أسست ناديا بجدة (اسمه: النادي الإقليمي) ولكنه لم يفلح لوجود الأهلي والاتحاد! وكان جمهورنا أربعة أشخاص، أحدهم أخي!
ولعل أقسى مراحل عمري (وأخطرها وأجملها أيضا) أيامُ ثانوية الشاطئ الليلية، كنت على ظهر القلاب في النهار وعلى مقاعد الدراسة في الليل، كان عمري 22، وكان كتاب الأدب والنصوص رفيقي في القلاب لأحفظ ما قرّره أستاذنا السوداني من قصائد جاهلية وخطبة قس بن ساعدة الإيادي.
كانت الطفرة الأولى في عهد الملك خالد سببا في تركي الدراسة أنا وكثيرٌ من أبناء جيلي، لم نقاوم إغراء الأعمال الحرة، ولكن القرار الأخطر في حياتي كلها جاء ضحى اليوم الأول من أيام عيد الفطر عام 1401هـ حين اتخذت قرار العودة للدراسة من بوابة ثانوية الشاطئ الليلية بجدة.
التحاقي بالثانوية الليلية كان أخطر قرارات عمري، فحياتي بعدها ليست كحياتي قبلها، كان قرارا حاسما وناجحا ومؤثرا في مستقبلي، ثم كانت الجامعة المرحلةَ الأجمل والأمتع والأكثر إثراء وانفتاحا على المعرفة وأدوات البحث العلمي.
جئنا من خَلص وجبل عوف واستوطنا جِدة.. في تلك الحقبة عرفت شارع قابل وشارع العلوي وسوق الندى وباب مكة، ورأيت أم كلثوم في التلفزيون، وعرفت البيبسي والكوكاكولا والفانتا (لا أحد يعرفها اليوم) ورأيت لأول مرة الدجاج يشوى على شواية كهربائية! جدة في حياتي شيء عظيم فيها تشكل عقلي ووجداني.
الناس يكسرون جيم جدّة، وكل المصادر القديمة تضمّها، وتقول: جُدّة، ونشأت معركة أدبية على صفحات الجرائد بين حمد الجاسر وعبدالقدوس الأنصاري الذي شدّد النكير على الجاسر لأنه أجاز الضم والكسر. —— أقول: أرى أن لقول الجاسر وجها.
في تغريداتي هذه أفتّش في ذاكرتي وأكتب لمحاتٍ خاطفة من حياتي ولا أسرد أحداثا متسلسلة، فلا تعجب حين تراني أكتب شيئًا عن الجامعة ثم أتقهقر وأكتب ومضة عن طفولتي.. أنا لا أكتب سيرة ذاتية. سيرتي ستكون في مذكرات حرف علة إن شاء الله ويسّر.
حين أسّست (النادي الإقليمي) بجدة، الذي وصل عدد جماهيره إلى أربعة أشخاص، كنت أحلم بمنافسة الأهلي والاتحاد في جدة! كنت “كبتن” الفريق وألعب في قلب الدفاع أو المحور حسب الحاجة.. لكن الفريق تلاشى في عام 1405هـ وذاب كالملح.. ضاع الحلم!
أمضيت السنوات الست الأولى من عمري في البادية، في بيت من الشعر، نحلّ ونرتحل في السنة مرتين أو ثلاث، نتبع الغيث والخِصب، فعرفت البادية المحيطة بمكة وعرفت جبالها وأوديتها وخبتها ونبتها، ورعيت فيها البهم قبل انتقالنا إلى جدة عام ١٣٨٥هـ واستقرارنا وتغيّرِ حياتنا في عهد الملك فيصل.
في طفولتي كنت مشدودًا إلى السماء والنجوم والمجرة التي كانت تظهر بوضوح في سمائنا قبل الكهرباء، أستلقي على ظهري وأعد النجوم وأعجب من ثباتها في السماء وما الذي يمسك القمر؟ وكانت أمي -رحمها الله- تجيب عن بعض أسئلتي وتسكت عن بعض.
للعين العزيزية أثر عميق في وجداني، كانت أمّنا الحنون، في مسجدها نصلي الجمعة ونصلي العيد، وفي حضنها مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية، ولا أنسى فضل حامد الحرازي، فهو من ذهب بي إلى السبعة القصور لتسجيلي بعد أن اُخذت لي هذه الصورة التي ترونها.. كانت في أستديو الشعب بباب مكة.
من المحن التي واجهتني في السنة الأولى عجزي عن كتابة حرف الطاء، أبكاني هذا الحرف الشقي، كأنّه طبلة عود طلال مداح، ثم غلبته بعد شهرين، وتطورت قدراتي في الإملاء حتى استطعت كتابة اسم (شنيفيص) على هامش جزء عمّ!!
أدين لحقبة الستينيات والسبعينيات الميلادية بالكثير من تكويني العاطفي والنفسي، وفيها تشكلت ذائقتي في الأدب والثقافة والفنّ. وفي أعماقي اليوم شجنٌ وحنين لتلك الحقبة الرائعة.
تفتّحت عينايَ على الدنيا والملك فيصل يتربّع على عرش البلاد، كان ملكا عظيما ذا شخصية أسطورية، ربما يقشعر جسدي حين أرى صورته أو أسمع خطبه وكلماته في الإذاعة أيام التضامن الإسلامي، كان الشعب يحبه، ويوم وفاته بكى والدي وأما أمي فرفضت فكرة موته، وأما أنا فكنت أظن أن الملوك لا يموتون.
أول وظيفة في حياتي كانت في مصنع للنسيج (لباس الإحرام) في ك 14 بجدة، عملت في الإجازة الصيفية حين كنت طالبا في المرحلة المتوسطة، أغراني الراتب الكبير، 100 ريال شهريا، ولأني غبت أيامًا كان أول راتب تقاضيته 65 ريالا، خبّاته في جيبي بعناية، ولك أن تتخييل فرحتي وإحساسي بالغنى المفاجئ!
فرّاج بن دخيّل (1349- 1430هـ) والدي رحمه الله، رجل كريم سخيّ النفس يعطي ما في يده ولا يفكر في غده، يطغى على حياته الرضا والسماحة والإيمان العميق. كان يخشى فقدي (بعد أن فقد شقيقي البكر “لافي” طفلا) فأحاطني بحنانه ورعايته وربما أخذت من الاهتمام والحب ما لم يأخذه أشقائي بعدي.
نورة بنت سليّم الطريس الحربي (1355- 1396هـ) أمّي رحمها الله، امرأة عظيمة، مؤمنة صابرة كريمة ذكية، تؤثِر على نفسها وقد كان بها خصاصة.. ماتت أمي في الـ 41 من عمرها، ماتت بمضاعفات ربوٍ مزمن لم يعالج فأنهك جسدها.. ماتت ولم تشاهد أحدًا من أحفادها.. أكتب الآن ودمعتي على خدي .
كانت أمي تميل إلى الطب الشعبي، وتردّدت كثيرًا على العطارين في مكة ثم في جدة بباب مكة وسوق الندى وباب شريف، وما من عشبة أو دواء عند العطارين إلا وجرّبته، وجربت العلاج بالكي، وأتذكر عجوزا تأتيها وتكويها وكنت إذا رأيت مسمار الكيّ في النار أهرب من البيت حتى لا أسمع صرخة أمي.
في أيام التعافي كانت أمّي تحجّينا بحجاويها أي تحكي لنا أنا وأخوتي حكايات ما قبل النوم وتسرد ببراعة قصة (معضاد) و(شمس أُمّ العَبيد من أمس) و(حرامي البيض) و(الدنجيرة) (والهويلة اللي رجلها رجل حمار!!) وكانت حجاويها ممتعة ومخيفة أيضا، كانت كأفلام الكرتون للجيل الذي جاء بعدنا.
كان يومي الأول في مدرستي مثيرا، كنت أنتظر الصرفة لأُري أمي كتبي، وفي الطريق الطويل لم أصبر، جلست وفتحت الشنطة لأتصفح الكتب، كانت الرياح جنوبية شديدة من خلفي، فطار كتاب الهجاء، فلحقته فلما أمسكت به طار جزء عمّ وطار كتاب آخر!! ركضت وجمعتها وقد تمزق بعضها.. جئتُ أمّي باكيًا!!
في الصرفة وأنا في الصف السادس وقعت مضاربة بيني وبين أحد الطلاب، خربشت وجهه وعضّ أذني، وفي اليوم الثاني اشتكاني لمدير المدرسة، قال المدير: لماذا ضربت الولد؟ قلت: (قال اسم أمي قدام الطلاب!) ضحك المدير، وقال: يا سلام! قال اسم أمك؟! أهب عليكم يالبدو، انقلعوا ولا عاد تتضاربون.
موت شقيقي “لافي” جعلني أكبر أخوتي، وحمّلني المسؤولية مبكرا، ومنها رَعْي الغنم، ولكنه أتاح لي رعاية خاصة من والدي رحمه الله، كنت طفله المدلل، أحاطني بحبه وحنانه، وأتذكّره حين يحملني على كتفيه ورجلايَ تتدلّيان على صدره، ولما بلغت السادسة كنت رفيقه حين يذهب إلى سوق جَرْوَل بمكة.
وفي عام 1385 كنا في اللحيانية شمال مكة (نسكن في بيت شعر) فزارنا زائر ثقيل ليأخذ شقيقتي عائشة الرضيعة، هنيئا لعائشة موتها، بكت أمي كثيرا وكنت أراقبها تمسح دموعها وأنا أفكّر في لغز الموت!! خرجت روح عائشة من الأرض إلى السماء بضمانة إلاهية بأن تكون من أهل الجنة.. ليتني متّ في سِنّها!
كان أحمد شوقي يقول: الحياة الحبّ والحبّ الحياة، وأما علي الطنطاوي فيقول: الحياة الذكريات،
ويقول النابغة الجعدي:
تَذَكَّرْتُ شَيْئًا قد مَضَى لسَبِيلِهِ ***ومِنْ عادةِ المَحْزُونِ أَنْ يَتَذَكَّرَا
ويقول الهمذاني :
أرى الأيامَ لا تُبقي*** على حالٍ فأحكيها
عندنا ثلاث دجاجات وديك، وكانت أُمّي تجمع البيض وأبيعه لها في باب مكة، يشتريه عليان الجلسي، (مشهور في باب مكة) يأخذ خمس بيضات بريال، كان يجلس على باب دكانه، ويفحص البيضة على لمبة كهرباء، ويستبعد الفاسد، وإذا رجعت البيت تكافئني أمي بريال، والباقي لدعم خزينة البيت الفارغة دائما!!
خلف بيتنا في ك 14 جبل، وفي الليل ينسلّ منه ثعلب يغزو دجاجات أمي. نصبنا له فخّا وصدناه، وعرضناه على حديقة الحيوان بجدة، كنا نحلم بالثراء ولكن المسؤول المصري أبى أن يشتريه بأكثر من 4 ريال، قال: رجله مكسورة وربما يموت، أخذنا الـ 4 ريال وأنفقناها أجرة لحافلات خط البلدة ذهابا وإيابا.
في مدرستنا الابتدائية صواعد وحرازات، كان بيننا وبينهم صولات وجولات من المضاربات بعد الصرفة، ولا أنسى (وقعة الماسورة) هدّدني كبير الحرازات في الفسحة وقال (الوعد الصرفة راح أنتف ريشك!) فأخبرت كبيرنا، قال: لا تشيل همه، ولما انتهت المعركة انشغل كل فريق بلملمة جراحه.
قلت لأمي: عيال الحرازات معهم قرصان بالزيت لذيذة (من صنع أمهاتهم) يأكلونها في الفسحة، خبزت لي أمي فطائر على الصاج، وضعتها في شنطة عبدالعاطي ولد خالي (ثانية ابتدائي وأنا رابعة) وقبل الطابور جاءني يركض، وهمس في أذني بحذر: (القرصان فاحتْ ريحتها في الفصل!! وش الحل؟) قلت نأكلها الآن!
وكبرنا، وتزوجنا، ولكننا لم ننس ذلك اليوم حين أردنا تقليد عيال الحرازات، الله يذكرهم بالخير.. واليوم إذا رآني أبو عاصم (عبدالعاطي) قال لي: (القرصان فاحت ريحتها!) فأقول له: (نأكلها الآن) ونضحك ونبتهج وفي صدورنا شجن وحنين لأيام الطفولة الخالية من هموم الحياة.
أول كسوف للشمس شاهدته ووعيته كان في عام 1967 الساعة التاسعة، حدثنا عنه قبل يوم من وقوعه معلمنا عبيد أبو قسمين، يبدو أنه قرأ خبره في صحيفه، قلت في نفسي: كيف يعلمون بحدوث الكسوف قبل وقوعه؟ كان ذلك من الألغاز التي تشغل عقلي الصغير، وسألت أمي عنه: قالت: الكسوف بسبب المنكرات!
شاهدت السينما أول مرة في حياتي في مدرستنا الابتدائية، في ك 14، كانت لقطات سينمائية في فيزياء الطيران وهندسة جناح الطائرة وكيف يحدث الضغط أسفل الجناح مع تسارع الطائرة فيرفعها الهواء ولو كان وزنها مئات الأطنان! أدهشتني الفيزياء وأخبرت أمي بما رأيت. قالت: العلم بحر.
في أيام الابتدائية كان طعامنا الماء والتمر والعصيدة، ثم تعرّفنا على رزّ البكة، كانت أمي تضع سلة التمر في برميل مفتوح من أعلاه، وكنا نلعب في النهار وإذا جعنا جئنا إلى برميل الخير.. جئت يوما لأخذ حصتي من التمر ففوجئت بشقيقي عبداللطيف داخل البرميل يأكل تمرًا، كان عمرة 4 سنوات!
قُبيل الغروب وفي كل مساء كانت تلاوة عبدالله خياط تهطل على أسماعنا من مذياع أمي الموضوع فوق رف الصندقة، كان صوته يبعث السكينة في قلوبنا، وكنت أسمع مذيعا ذا صوت مجلجل -لعله عبدالله راجح- وهو يقرأ بصوته الفريد: (وأنا ربكم فاعبدون) فتعتريني قشعريرة ورهبة، كنت أظنه الله سبحانه!
أمّي تقول لي: أنت زَرْم (زَرِم على وزن فَعِل صفة مشبّهة) أي تشيل هموم الدنيا على رأسك، ومن همومي الامتحانات -قبل أن يغيروا اسمها إلى الاختبارات- كانت تخيفني، وأنا أفهم من شرح المدرّس ويشقّ عليّ الحفظ.
كان والدي كثير التمثّل في كلامه بالأمثال، ومن أمثاله قوله حين يجور عليه الزمان: (غِنِيمات فَقْريمات) بهذه الصورة ينطقها، ولم أكن أفهم معناها، وعرفته حين كبرت، يقول: (غِنِي مات فَقْري مات) كان -رحمه الله- قنوعا زاهدا يجود بما في يده.
ضعت في الحرم سنة 1384 وانتابني خوف بأنني لن أجد أمي، رآني عسكري وقرأ ملامح وجهي فأمسك بيدي، قال: ما بك؟ قلت: ضيّعت أمي! قال: لا تقلق يا ولدي سنجد أمك، وطال البحث ثم عرفتها في الزحام بلون “كرتتها” المرصعة بورود صفراء كبيرة كعباد الشمس، فارتميت في حضنها وأجهشت بالبكاء.
أنا من جيل (لا ترمِ قشر الموز) مع أننا لم نكن نعرف الموز، ولو عرفناه فليس لدينا أرصفة في ذلك الزمن، ولكن كتاب المطالعة متمسّك بهذه النصيحة المهمة ويرى أنها أنقذت كثيرين من أبناء جيلي! كما يصر كتاب التاريخ والجغرافيا على أن أبرز الصناعات في الدول العربية والإسلامية: دباغة الجلود!!
كان مصروفي اليومي نصف ريال، أشتري نصف تميس وصحن فول من العم إسماعيل حسن بخمسة قروش، وكوكاكولا أو ميرندا بخمسة قروش (ننطقها: بَرَنْدا) وأشتري بالباقي من بقالة حمد أو دودان الشريف بسكوتا وحلويات، وكنت أضعها في جيبي لأشقائي الصغار الذين لم يدخلوا المدرسة بعد.
المسافة بين بيتنا والمدرسة نحو 1800م وكنا نمشيها مرتين ذهابا وإيابا كل يوم، وفي صباح يوم من أيام الشتاء لبست ثوبي وحملت حقيبتي ولكني لم أجد فردةً من حذائي (مداسي)، قالت أمي: لا تذهب للمدرسة، لكنني خالفتها ولبست الفردة الوحيدة ومشيت كالأعرج، وبعد 300 متر رجعت لأمي وأنا أبكي.
قالت أمي لأبي: ثوب عبدالرزاق مشقوق وقصير (ثوب العام الماضي)، وما عنده غيره. أخذني أبي إلى باب مكة واشترى لي ثوبا جديدا وطاقية وحذاء بسبعة ريالات، وأتذكر لونه المستكاوي وإزراره الذهبي عند الحلق، فلما لبست الثوب والطاقية المنقوشة والحذاء في الغد كنت أمشي في طابور المدرسة كالطاووس !
كان عندنا أربع عنزات حلايب، هنّ مصدر حليبنا وبعض رزقنا، وعند ولادتهن نستمتع أنا وأشقائي باللبا.. كانت إحداهنّ شرهة للطعام، تسميها أمي: (الغَهْبة) تأكل كل شيء، ومما أكلته: كتاب الهجاء! أكلت ثلثه فأتت على صفحات درس وزرع وحصد.. وكانت أول الصفحات السالمات صفحة القرد والنجار!
زارتنا عجوز من جارات أمي وطلبت ألواح خشب كنا نلعب بها أنا وأشقائي، وافقت أمي بسماحتها المعهودة، لكنني رفضت وأصررت على الرفض، فغضبت العجوز وشتمتني بكلمات مبهمة ودعت عليَّ دعوة غريبة، قالت: (جِعْل البنات ينعدمن) أي عساك لا تجد بنتا تتزوجها إذا كبرت!! الحمد لله دعوتها خابت!
لا أتذكّر شيئًا من عهد الملك سعود، لقد وَعَى عقلي على عهد الملك فيصل، كان والدي متسببا يطارد رزقه ويصارع الحياة لتوفير لقمة العيش لأطفاله، يطوي بيت الشعر في السنة مرتين تتبعا لمواقع الخصب من أجل عنزاته القليلة، ثم تحسنت أحواله حين وجد وظيفةَ سائق قلاب بـ 250 ريالا.
تحسنت أحوالنا حين توظف والدي عند (عبدالله بن منور)، سائق قلاب من نوع فورد، موديل 59، (كان عبدالله بن منور رجلا كريما صاحب مواقف مشرّفة مع جماعته- رحمه الله) وفي السنة الأولى لوالدي في القلاب اشتغل في مشروع ميناء الوجه، وغاب عنا 4 أشهر، كان عمري 6 سنوات وكانت أمي تعتمد عليّ.
أخبرني قريب لنا بعد أن كبرت، قال: في ميناء الوجه عانى أبوك من مشكلات مع القلاب، لكثرة أعطال “الكربريتر” و”الأبلاتين” و”البواجي”، قال: وبلغ به اليأس أني سمعته يقول وهو ينظر إلى البحر: سأربط نفسي وأغوص بقلابي في البحر.. قالها لينفّس عن نفسه.. رحمه الله كم شقى وتعب من أجلنا.
كان انتقالنا إلى جدة حدثا عظيمًا في حياتنا، وزاد راتب والدي فبلغ 450، وعرفنا البرتقال وعمري 9 سنوات، وذقنا أول دجاجة محمّرة في حياتنا اشتراها والدي من مطعم في ك 6 بجوار السينالكو، أكلناها أنا وأخواني بعظامها وإلى اليوم أتذكر طعمها، ثم عرفنا الجبنة والحلاوة.. بدأنا نشعر بالغِنى !
كانت مدينة جدة بضواحيها البعيدة ومنها العين العزيزية بكيلو ١٤ حين سكناها في 1386هـ عروسًا شابة تلبس ثوبًا قصيرًا من العمران فوق الركبة، وكان ثوبها ينتهي بكيلو 6 شرقا ومحطة بافيل شمالا.. أحببت جدة القديمة حبا فأكاد أبكي حين أتذكرها ولا أدري أكان الجمال جمالها أم جمال الطفولة!
في طفولتي الأولى كان بيتنا (بيت شعر) يقينا الشمس والمطر والبرد، وفي عام 1387هـ كان التحوّل العظيم، اشترى والدي صندقة من مكة، ولا أنسى ما حييت لحظات وصولها صلاةَ العصر في لوري، رُكّبت الصندقة قبل المغرب، وتوافد جماعتنا للمساعدة وتهنئة والدي، كانت لحظات تاريخية محفورة في ذاكرتي.
صلَّوا المغرب، وجلسوا على حصير بجوار الصندقة لاستكمال التهاني والدعاء بالبركة. أما أنا فكنت أصبّ القهوة والشاي، وكنت أسمع والدي يجيب -بفخر وثقة- عن أسئلتهم عن جودة الصندقة وثمنها وقدرتها على تحمّل الريّاح والمطر، ثم بعد أشهر قليلة انتشرت ثقافة الصنادق في ك 14 تقليدًا لوالدي.
في خامسة ابتدائي مرضت ولزمت الفراش شهرين، كدت أموت، قال أبي: لازم نكويه، وفي المساء تحلّقوا حول النار، ورأيت رأس المسمار أحمر كالدم، حاولت الهرب، ولكنهم أمسكوني ووضعوا رأس المسمار في مواضع من صدري وبطني، وارتفعت رائحة الشواط واختلطت بصراخي الذي سمعته عنزاتنا ودجاجات أمي!
بعد أسبوع من الكي دبّت العافية في جسدي النحيل، وخرجتُ ألعب، قال زميلي في الصف عاتق عبدالله (رجل أعمال حاليا): المدير يسأل عنك، ويقول: لا تترك المدرسة، قلت: كيف أنجح؟ قال: أخذنا الكسور العشرية في مادة الحساب، وهي سهلة، وشرحها لي عاتق بإصبعه على التراب، ففهمتها وانشرحت نفسي للمدرسة
قلت لأمي: أبغى بسكليتة (دراجة) قالت: (قولْ لأبوك)، فقال أبي: ما تصلح لك الدراجة يا ولدي، فكررت الطلب فقال على سبيل التيئيس والتقنيط: (لو تلحس إذنك ما شريتها لك)، ومرة قال: (لو ينبت في راسك نخلة!) ثم علمت فيما بعد أنه لم يكن يملك ثمن الدراجة رحمهما الله كما ربياني صغيرا.
وبعد سنة أعدت طلب الدرّاجة وألححتُ على والدي وساعدتني أمي هذه المرّة، قال: أبشر، وفي باب مكة قال بائع الدراجات اليمني: هذي الدراجة ماركة همبر، وهذي لاري، وهذي مالها اسم، قلت وش الأحسن يا عم؟ قال: (همبر تمشي وتتقمبر) و(لاري تمشي وتباري) قلت: أبغى لاري.
وركبنا أنا ودرّاجتي “اللاري” في صندوق القلاب، خشيتُ عليها أن تكون وحيدةً أو تسقط على جنبها، كنت بجوارها متشبّثا بها أختبر الجرس بأصبعي بين الحين والحين، (لا أستطيع اليوم وصف صلصلة ذلك الجرس ووقعه في قلبي قبل أذني) ونُمت أول ليلة دون لحاف لأنني غطّيت دراجتي بلحافي من زود الحرص!!
ذاكرتي مسكونة بالنصف الثاني من حقبة الستينيات ومطلع السبعينيات. كنت طفلا حين تفتّحت عيني على الحياة والأحداث. عشت انتصارات العرب (الإعلامية) في حرب67 وكان مدرس الرسم يرسم طائرات العرب على جدار المقصف وهي تقصف طائرات إسرائيل وتسقط في كل يوم60 طائرة! كما تقول بعض الإذاعات العربية!
وتفتّحت عيني على دعوة الملك فيصل للتضامن الإسلامية، وزياراته لدول الشرق والغرب وأفريقيا، وكانت جدة قبلة رؤساء العالم العربي والإسلامي، لا يكاد يمضي أسبوع دون قدوم رئيسٍ أو ملكٍ زائر، وكانت مدرستنا تجمع طلاب الفصلين السادس والخامس للمشاركة في الاستقبال على جانبي طريق الموكب.
وكانت فرحتنا كبيرة لأننا نشارك في الاستقبال، نقف في صفوف طويلة على الطريق الخارج من مطار جدة وبأيدينا الأعلام نلوّح بها عند قدوم الموكب وأعيننا على السيارة الملكية التي تقلّ الملك وضيفه، ومن ضيوف الفيصل الذين أتذكّرهم: الملك حسين وحافظ الأسد وسليمان فرنجية والحبيب بو رقيبة.
وفي زيارة الرئيس اللبناني سليمان فرنجية ركبنا الأتوبيس، وكان المسجل الكبير يصدح بنشيد محمد عبده: (كلنا فيصل، كلنا خالد) ونحن نردد وراءه، ثم اتخذنا مواقعنا على الطريق وحين عبر الموكب أمامنا رأينا الفيصل وبجواره سليمان فرنجية، وكنا نردد: أهلا أهلا يا سليمان، أهلا أهلا ضيفَ الفيصل.
وفي العودة ونحن نتكدّس داخل الباص الأصفر ويملؤنا الشعور بالرضا والحبور نردّد بأصوات طفولية “حادّة” خلف معلمنا محمد ساعد وهو ينشد بنشوة: (رحنا وجينا فايزين أكلنا حلاوة نارجين).. ثم تكتمل الصورة البهية في المساء حين نروي لأمهاتنا باستمتاع بالغ مشاهداتنا للموكب الملكي المهيب.
بيننا وبين التخرّج عقبة الامتحانات النهائية، كان لشهادة الابتدائية في زماننا شنّة ورنّة، قررتْ إدارة التعليم بجدة أن “تمتحنّا” في مدرسة محايدة في ك 6 مدرسة سعد بن معاذ، أرعبونا بأرقام الجلوس! جلسنا نترقب الأسئلة بخوف وقلق وتوتّر، ستة أيام من الامتحانات والتوتّر.
كانت الإذاعة تعلن أسماء الناجحين، بعد نشرات الأخبار، وما أقسى قلب المذيع حين يقول: (مدرسة كذا.. لم ينجح أحد) ولقد طال انتظارنا (سبعة أيام) كأنها سبعة أشهر، قال لنا مدير المدرسة الأستاذ عبيد أبو قسمين: غدا ستسمعون من الإذاعة أسماء الناجحين.. دعا لنا بالتوفيق والنجاح.
كنت قريبا من مذياع أمي (الرادي) أترقّب اسمي بمشاعر مختلطة من الرجاء واليأس، شرع المذيع في إعلان النتائج، قلبي يخفق، زاد الخفقان حين قال المذيع: (مدرسة علي بن أبي طالب) وكلما قال: عبدالـ… فزّ قلبي حتى سمعته يقول: (عبدالرزاق فراج الحربي) كاد قلبي يقع من الفرحة!
وسمعت أسماء زملائي، ثم خرجت مبتهجًا والتقيت بعضهم، كنا ننثر الفرح في كل مكان، قال: عاتق عبدالله: لم نسمع اسم حـ… فذهبنا إلى بيتهم (صندقتهم) فوجدناه منطويًا في الركن يبكي، وقفنا ننظر إليه بصمت، لم نعرف كيف نواسيه (رحمتُهُ في نفسي!) قال عاتق: إن شاء الله تنجح في الدورالثاني.
كان سماع اسمي في الإذاعة حدثًا مهمًّا وملهمًا لي، به طُويتْ صفحةٌ في حياتي وفُتحتْ صفحة جديدة، أخذتُ ملفي الأخضر واتجهتُ إلى متوسطة ابن سيناء بمدائن الفهد (كيلو 5) كان ذلك في عام 1392هـ 1972م وفي المتوسطة بدأ الشاب المراهق ينبعث من تحت جلد الطفل!
كان حصولي على الشهادة الابتدائية أول إنجاز في حياتي، امتلأت نفسي بالرغبة في تحقيق إنجاز آخر، عيني على شهادة المرحلة المتوسطة، (نسميها: الكفاءة) كانت الكفاءة مفتاح الأحلام، وحلمي أن أكون (طيارا) ولكن الحلم لم يتحقق فأصبحت بعد المتوسطة (سائق قلاب!).
لا أكتب سيرة ذاتية، ولكني أروي من الأحداث والمواقف ما بقي محفورًا في ذاكرتي مما تأثّرتْ به نفسي أو غيّر مجرى حياتي، وأحكي بعض مشاهداتي وانطباعاتي ونجاحاتي وانكساراتي. ونواصل البوح بعد العيد إن شاء الله.
كان ولد عمي الأكبر يعدد لي ما يراه وما يسمعه في باب مكة وشارع العلوي ويصف لي الفول، ويقول: (لذيذ ما عمري ذقت مثله) وبعد شهر كنت في باب مكة مع والدي فقلت: أبغى فول! فدخلنا زقاقا قادنا إلى فوّال يمني، كنت أتأمل جرّة الفول بإعجاب بالغ، ثم بقيت أسبوعا أصف لأخوتي الفول وجرّة الفول!
بعد تخرّجي من مدرسة علي بن أبي طالب في ك 14 ذهبت بملفّي إلى متوسطة ابن سيناء في مدائن الفهد (ك 5) وهي أقرب متوسطة لنا، دخلت غرفة المدير وأعطيته ملفي، كان متجهّما صارما على عينيه نظارة تخفي قسوة نظراته، وفيما بعد كنا نسميه (أبو كلبشة) تغيّر علينا كل شيء، المكان والمدرسون والطلاب.
نخرج في الصباح ونمشي مسافة 1800م سيرا، ثم نقف على قارعة الطريق بجوار العين العزيزية نتوسل من يقف ويأخذنا في طريقه حسبة، ثلاث سنوات في المتوسطة على هذه الحال، وأذكر مرّة وقف لنا صاحب ونيت، وقال أوصلكم بريال لكل راكب، وافقنا، فلما وصلنا ونزلنا أطلقنا سيقاننا للريح وهو يصرخ وراءنا !
في متوسطة ابن سيناء في ك5 تعلمت ثقافة جديدة، كان الطلاب من شرائح مختلفة من المجتمع، من الأغنياء ومن الكادحين، وأتذكر أبناء الشربتلي، محمد وفيصل شربتلي، كان فيصل وسيما يلبس ثيابا بيضاء غاية في النقاء والنعومة والنظافة، ولا عهد لنا بالملابس النقية المكوية، كنت في الطابور أتأمل ثوبه
استدعاني المدير أنا وبعض زملائي، قال: وش هالثياب المكرمشة؟ بكرة تكوي ثوبك يا ولد أنت ويّاه. تشاورنا في الصرفة، وقلت لهم: عندي فكرة، سأفرش ثوبي تحت الطراحة وأنام عليه وفي الصباح سأجده مكويًّا! فعلتها وفي الصباح وجدت ثوبي معفوسًا غارقًا في العرق! فغبت ذاك اليوم !
في المتوسطة تلك، كان في فصلي طالب عراقي اسمه ماجد السعدون (لعله ابن السفير العراقي) يمتلك كتبًا (قصص أطفال) مثل طرزان وبات مان وسوبرمان والوطواط والبرق وطارق، يعرضها للإيجار، أستعرت بعضها، 4 قروش لكل كتاب، كان عقله عقل تاجر وأنا عقلي عقل مستهلك !
قرأتها كلها، وأشركت أشقّائي معي، وفي ليلةٍ كنت مستلقيًا على ظهري في الصندقة تحت الناموسية، ورأسي خارجها من أجل ضوء الفانوس عند رأسي، غلبني النوم، ولم أنتبه إلا وأبي يحاول إطفاء النار التي اشتعلت في الناموسية حين أسقطت الفانوس بيدي وأنا نائم، وكادت صندقتنا تحترق لولا لطف الله.
أتذكّر بعض من درّسنا في متوسطة ابن سيناء منهم مدرّس الإنقليزي محمد الزعبي (سوري) ومحمد سعيد، والفلاتة، ومحمد عبدالرزاق (أعجبني اسمه!) ومدرس الفقه باجابر، وكان يحدّثنا عن بويضة المرأة والدورة الشهرية، ونحن في السنة الثانية المتوسطة!!
ومن زملائي الطلاب: عاتق عبدالله (رجل أعمال) وعيال العمودي وأيمن بسيوني ووهيب خليل (أظنه الآن معلقا رياضيا لكرة السلة) وعلي مرزوق وصالح مرزوق ومحمد عبيد الجمعي (رحمه الله) وسعود مسعود وشريقي ناشي الجابري (الدكتور لاحقا) وعيال الشربتلي محمد وفيصل، وكانوا قبلي بسنة.
ولم نزل نتذكّر أنا وجيلي ونحن في المرحلة المتوسطة حين غمرت العالم العربي موجة تجديد النحو، واكتشف المجدّدون -لله درّهم- أن صعوبة النحو تكمن في تعدد مصطلحاته، كالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل، فخرجوا علينا ببدعة المسند والمسند إليه، فما زادونا إلا خَبالا !
في السنة الثالثة المتوسطة كنت أعاني من مادة الجبر، مدرسها كثير الغياب وغير قادر على الإفهام، ومن مسائلها: أ / س ص + س ع = س (ص + ع) ب / 6س – 2 س ل = 2 س (3 – ل) ج / ن (س – ص) + م (س- ص) = (س – ص) (ن + م) لم أفهمها، وأظنني نجحت بدعاء الوالدين!
في السنة الثالثة (يسمونها الكفاءة) اختبرونا في مدرسة في حي الكندرة، كان ضرسي ملتهبا، وخدي الأيسر منتفخا، وفي الصباح قبل الاختبار، ابتعدت عن باب المدرسة وفرشت كرتونا على الرصيف وأنسدحت عليه أتلوّى من ألم الضرس، وأصدقكم القول: لا أدري كيف نجحت؟ قطعا كان دعاء الوالدين يحوطني.
سمعت اسمي في الإذاعة ضمن الناجحين، (نتائج الكفاءة في تعليم جدة) قال المذيع: مدرسة ابن سيناء المتوسطة وشرع في سرد الأسماء وقلبي يخفق خوفا وقلقا.. الله الله لقد فعلتُها، لقد نجحت!! رغم أنف الضرس الملتهب أيام الاختبارات، ورغم أنف مادة الجبر، وجزى الله خيرا من اخترع درجات الرحمة!
بعد حصولي على الكفاءة في عام 1395هـ انفرط عقد الزملاء، تركوا الدراسة والتحقوا بركب الطفرة، لم يبق أحد في المدرسة ممن أعرفهم.. لحقتُ بهم.. ستّ سنوات من التيه على ظهر القلاب، وكان دخلي الشهري يزيد عن 12 ألفا، وكنا ننظر إلى من واصل تعليمه بأنه أحمق لا يعرف مصلحته !
ست سنوات على ظهر القلاب، من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، كانت سنوات التيه من عمري، على الرغم من جمالها وتأثيرها الإيجابي الكبير في حياتي، لقد عشت بها حياة الكادحين المتوثّبين وفرّغت فيها فورة المراهقة وقهرت الطيش، كنت كادحا طموحا متذوّقا شغوفا بالحياة.
قادني طموحي وشغفي بالعلم إلى أبواب المرحلة الثانوية.. جاءت لحظة التحوّل الحاسمة في صباح يوم العيد الأضحى من عام 1402هـ، في بيت بخيت سعد، قلت له: سمعت أن ثانوية الشاطي ستفتح المسار الليلي هذا العام، سأعود إلى الدراسة، كان قرارا عاجلا ومفاجئا، أدهش زملائي، ولم يلبثوا أن حذوا حذوي.
في ثانوية الشاطئ تأثرت بأستاذين سودانيين: الأستاذ (يحيى موسى) وكان بارعا في النحو، شربنا من كأسه الإعراب شربا. والأستاذ (الطاهر حسن) وكان بارعا في الأدب، تذوّقنا معه الأدب الجاهلي. وظهر أثرهما في تكويني العلمي حين دخلت الجامعة وتخصصت في اللغة العربية. لا أنسى فضلهما عليّ ما حييت.
بعد مغادرتي الثانوية بعشر سنوات وأنا في المدينة، تذكرت أستاذي السوداني يحيى الذي حبّبني في النحو، حصلتُ على رقم الثانوية واتصلت ضحى أحد الأيام وسألت عن الأستاذ يحيى لأسمع صوته وأجدد العهد به، فقال لي وكيل المدرسة: الأستاذ يحيى نُقل إلى مدرسة أخرى، ثم سكت برهةً، وسمعته يقول: سبحان الله سبحان الله! هذا الأستاذ يحيى دخل مكتبي الآن زائرًا !
في المرحلة الثانوية قرأت كتاب وِلْ ديورانت (قصة الفلسفة) ترجمة أحمد الشيباني، وقرأت قبله كتابا يتناول سيرة الفيزيائي الشهير آينشتاين ونظريته (النسبية العامة) كتبه عبدالرحمن مرحبا. وكان لهذين الكتابين أثرٌ عميق في عقلي ونفسي.
تفتّح عقلي الصغير في عهد الملك فيصل والملك خالد، وكانت الإذاعات تصدح بالغناء لعباقرة الموسيقى العربية، فتعوّدت أذني على الفن الأصيل قبل أن يتعكّر ويُبتذل، والفن الأصيل يبعث في النفس أحسن ما فيها ويخفي أقبح ما فيها.
كان جيلي يسمع شعبيات حجاب بن نحيت وخلف بن هذّال وطاهر علي الأحسائي وعيسى الأحسائي، وكنت مثلهم، ثم ترّقى ذوقى وألِفتْ أذني أسطوانات كوكب الشرق وملحنيها الكبار كالسنباطي والقصبجي والموجي وزكريا أحمد وعبدالوهاب وبليغ حمدي.. تذوقتُ الروائع وأنا في حَوْمة المراهقة.
كان زملائي في الثانوية موظفين، وكنت أوهمهم بأنني موظف أيضًا، (شعور بالنقص) وفي أحد الأيام تأخّرت في العمل وأوشكت الشمس أن تغيب، فاتجهت مباشرة إلى المدرسة وأخفيت القلاب بعيدًا عن العيون خلف المدرسة، لأنني كنت أدّعي حين يسألونني بأنني موظف في البلدية! ليتني قلت الخطوط السعودية!
ثلاث سنوات ثقيلة أمضيتها دون إجازة، سوى إجازات العيد، كنت أعمل من الفجر إلى العصر وأجلس في الليل على مقاعد الدراسة، ومما خفّف قسوة العمل في القلاب أنني كنت مديرَ نفسي، فلما اقتربتْ امتحانات السنة الثالثة التي نسمّيها (التوجيهي) منحت نفسي إجازة شهر لتحقيق الحلم، كان حلمي الجامعة.
حصلت على الثانوية بتقدير جيّد جدا مرتفع، قسوة العمل في القلاب حجبت عني الامتياز، فكان أول قرار اتخذته هو بيع القلاب والتخلّص منه، كان طموحي الجامعة، فذهبت بملفّي إلى عميد القبول والتسجيل (د. مازن بليلة) قبلت في كلية الآداب، فوسوس لي زميل قديم بأن كلية المعلمين أجدى وأسرع تخرجا !
سحبتُ ملفّي من الجامعة واتجهت إلى كلية المعلمين بمكة، وفي اليوم التالي سحبتُ ملفّي ورجعتُ إلى الجامعة، وبعد يومين سحبتُ ملفّي من الجامعة ورجعتُ إلى مكة، ثم ندمتُ وسحبتُ ملفّي ورجعتُ إلى الجامعة، غضب د. مازن بليلة، وقال لي: أنت تلعب؟! إن سحبتَ ملفّك لا عاد أشوفك !
كنا في الفصل الأول نُسمَّى: طلاب جامعة، وهي مرحلة ما قبل التخصص، وفي الفصل الثاني نتخذ قرار التخصص، ترددت من جديد، ومن عادتي التردّد والحيرة عند مفترق الطرق، ترددت بين قسمين: اللغة العربية واللغة الإنقليزية، قُبلت في اللغة الإنقليزية، ثم سحبت ملفي واتجهت إلى اللغة العربية.
في كلية الآداب بالجامعة العزيزية تفتّحت لي أبواب المعارف، أبواب اللغة والأدب وتعرّفت على أدبيات البحث العلمي ومناهجه، ورأيت مزيجًا متنوعًا أشدّ التنوع من الأكاديمين المؤثرين في اللغة والنحو والأدب والنقد والاجتماع وعلم النفس.. انغمست في بحر المعرفة حتى.. ثملت وطربت!
كنت طائشًا في مرحلة الطفولة، تائهًا في مرحلة القلاب، واكتشفت نفسي في مرحلة الثانوية الليلية، واستقرّت نفسي وحياتي في مرحلة الجامعة.. ويمكنني اليوم أن أقول: إن أجمل مراحل عمري كلها هي السنوات الأربع التي قضيتها في الجامعة العزيزية 1404- 1408هـ .
أزعم أنني الطالب الوحيد في تاريخ الجامعة العزيزية (جامعة المؤسس) الذي درس منتظمًا أربع سنوات ولم يغب محاضرة واحدة، نعم لم أغب قطّ ! وتستطيع الجامعة اليوم أن تكرمني بأثر رجعي! أوصلوا رسالتي هذه إلى جامعتي، لا لا أوصلوا رسالتي إلى الطلاب الذين أكبر همهم تعليق الدراسة !
رؤساء قسم اللغة العربية: عبدالهادي الفضلي كان أول رئيس للقسم 1398هـ، ثم عبدالله الغذامي سنة 1402هـ، ثم حسين الذواد 1404هـ ثم عبدالله المعطاني، ثم عبدالمحسن القحطاني مدة سنة فصدر قرار تعيينه عميدا للقبول والتسجيل، ثم عبدالله المعطاني مرة أخرى، ثم عبدالعزيز السبيل..
ثم جميل مغربي، ثم حمدان الزهراني، ثم عبدالله عويقل السلمي، ثم سعيد مسفر المالكي، ثم عبدالرحمن الوهّابي، ثم منصور ضباب، ثم عادل خميس الزهراني، ثم عبدالرحمن السلمي، ثم مصطفى مايابا، ثم محمد فايع عسيري، وهو رئيس القسم إلى تاريخ كتابة هذه التغريدة.
وكان قسم اللغة العربية حين درستُ فيه تتنازعه ثلاثة اتجاهات: اتجاه المحافظين، ويقوده عمر الطيب الساسي، واتجاه اللسانيين الحداثيين يقوده عبدالله الغذامي -وهو أكثرهم تأثيرًا في القسم وخارجه- وخليل عمايرة، واتجاه المعتدلين ومنهم عبدالمحسن القحطاني وعبدالله المعطاني.
في أيام الصراع بين المحافظين والحداثيين كنت طالبًا في الجامعة العزيزية، وكنا نرى لهيب المعركة الأدبية في قاعات المحاضرات وقاعات الأنشطة الأدبية في كلية الآداب، ونقرأ صدى ذلك في الصحف (المدينة وعكاظ والندوة) ونسمعه في نادي جدة الأدبي، ثم نقرأه في كتاب الحداثة في ميزان الإسلام.
قاد النزاع النقدي عبدالله الغذامي ومريدوه من جدة ومحمد المليباري ومريدوه من مكة، ولكل فريق أتباعٌ، واختلط الحابل بالنابل، فثمة أساتذة وطلاب لا ندري مع مَن هم، ورأينا فريقا ثالثا يتشكّل بصمت يميل إلى الوسطية والاعتدال، ويأخذ من الفريقين أحسن ما عندهما، وأنا من الفريق الثالث.
وكان في القسم نخبة من الأساتذة وصفوة من طلاب العلم الجادّين. وأتذكّر من أساتذتنا آنذاك: الفضلي، والتركستاني، والغذامي، والمعطاني، والقحطاني، وخليل عمايرة، والساسي، وبكري شيخ أمين، والسعيد الورقي، وفوزي عيسى، وحسين الذواد، وضيف الله هلال العتيبي، وعلي البطل، رحم الله من مات منهم.
نبتت الحداثة النقدية السعودية في جدة في منتصف القرن الرابع عشر حين خرج كتاب خواطر مصرحة لمحمد حسن عواد، ولكنها كانت حداثة عربية تلبس الغترة والعقال، كما قال بعض مؤرخي ثقافتنا، ولم تتصل أسبابها بالحداثة الغربية اللسانية التي حملت لواءها بنيوية دي سوسير وجماعة براغ.
وفي مطلع القرن الخامس عشر وضعت مدينة جدة اللبنة الأولى للحداثة البنيوية اللسانية حين استمع الناس لسعد مصلوح في محاضرة بعنوان (الاتجاه اللغوي في النقد الحديث) ثم ظهر كتاب (الخطيئة والتكفير) لأستاذنا عبدالله الغذامي في عام 1405هـ، فكان علامة فارقة في تاريخ الحداثة السعودية.
كان الغذامي يصدر عن معينٍ ألسني صريح، ومثله يوسف نور عوض خصمه اللدود، ويمكن للمراقب أن يفهم الخلاف بين الغذامي والملبيباري، ولكنه لا يدرك سر الخلاف بين الغذامي ويوسف نور عوض، مثلا، فهما يصدران عن معين واحد، الاتجاه النقدي البنيوي الذي نضج على يد جماعة براغ، ومنهم ياكبسون.
كان قدوة في الانضباط وحسن التعامل واحترام الرأي المخالف، كان حريصا على تكوين الشخصية العلمية المستقلة لطلابه.. درست عليه مقرري الأسلوب والنصوص الأدبية، كان مقرر الأسلوب في مسرح كلية الآداب لكثرة الطلاب (طلاب اللغة وطلاب الإعلام) في الفصل الأول من عام 1406هـ
لا أنسى موقفًا عابرًا ترك في نفسي أثرًا.. جئتُ أستاذي الغذامي مرة في مكتبه في كلية الآداب بعد أن درست عليه مقرر (الأسلوب)، فقلت له: أنا لست راضيا عن أدائي العلمي في هذه المقرر، فاعتدل في جلسته وأقبل عليَّ وهشّ وبشّ، وقال حين لا ترضى عن نفسك فأنت تضع قدمك على الطريق الصحيح!
بعد الأسلوب درسنا عليه مقرّر النصوص الأدبية في مبنى كلية الآداب، فجذبنا بأدبه وعمقه في تحليل شعر المتنبي، أحببت هذا المقرّر وأعطيته وقتي وحصَّلت فيه العلامة الكاملة.. لم يقتصر أثر الغذامي على هذا، فكنا نراه في الصف الأول في مسجد الجامعة في صلاة الظهر.. قال أحدهم: حداثي يصلي!!
استراحة من التذكّر صورة والدي -رحمه الله- حين كان في الأربعين وصورتي وأنا طالب في الجامعة العزيزية.
ومن المؤثّرين في تكويني العلمي ومساري اللغوي أستاذي الكبير د. محمد يعقوب تركستاني (مشرفي في الدكتوراه فيما بعد) كان قدوتنا في فقه العربية، يضرب بجديته وانضباطه ودقته وعشقه للتراث المثل، مع جزالة قوله حين يتحدث وجمال أسلوبه حين يكتب، وأما خطه فكان آيةً من آيات الجمال والإتقان.
وكان لأستاذنا التركستاني هيبةٌ وإجلال في نفوسنا، على الرغم من لطفه وتواضعه الجمّ، والهيبة رزق من الله، وقد درسنا عليه في الجامعة العزيزية (فقه اللغة) و(دراسات لغوية في القراءات القرانية) ومرّةً تأخرت في محاضرته الصباحية 10 دقائق، فأنا آتي للجامعة من ك 14، ولمت نفسي على ذلك.
وأفدتُ منه كثيرًا، وفي عام 1408هـ عَمِلتُ معه في ملحق التراث بجريدة المدينة في الإجازة، فلما رأى أستاذُنا الغذامي توجّهي التراثي وصلتي بالدكتور محمد يعقوب وظهور بعض مقالاتي وأنا طالب في المستوى الأخير بالجامعة قال لي وهو يبتسم: أخذك التركستاني! فقلت: مشيتُ مع هوى نفسي!
أما الدكتور عبدالله المعطاني فمن حسن حظنا أننا درسنا عليه مقرر المصادر الأدبية واللغوية -من كتاب عزّ الدين إسماعيل- في المستويات الدراسية الأولى، والمعطاني أديب وناقد وشاعر يمتلئ بالأصالة والتراث، فانتفعنا منه كثيرا في مقرري المصادر والنقد القديم.
حبّب إلينا أستاذنا مصادرَ العلم، وكان يرشدنا إلى أحسن الطبعات، وأذكر أنني أتيته مرّة بنسخة تجارية من (طبقات فحول الشعراء) لابن سلام، وكنت سعيدا بها، فلامني عليها، وقال لي: هذه لا تغني عن تحقيق محمود شاكر، فتعلّمنا منه ألا نقتني كتابًا محققًّا إلا بعد سؤال أهل العلم والدراية،
ثم أخذتْه منا الإدارةُ حين عُيّن وكيلا لكلّيّة الآداب عام 1407هـ، ولكنه كان حريصا جدًّا على تطوير القسم وإشباعه بالنشاط الثقافي، وأعترف اليوم أن الدكتور عبدالله المعطاني كان أحد المؤثرين في شخصيتي العلمية، وأدين له بالفضل كما أدين لجميع أساتذتي في ج العزيزية وج الإسلامية.
ومن أساتذتنا القريبين إلى نفوسنا، لعلمه وأدبه ودماثة خلقه ورجولته وشهامته واحترامه لطلابه الدكتور عبدالمحسن القحطاني.. أخذنا عنه الأصالة قبل العلم، ومن نبعه ذقنا علم العروض وسبحنا في بحوره.
بدأ القحطاني من أصغر التفعيلات، ومن أيسر البحور، وارتقى بنا في سلّم العروض، صعدنا معه إلى الطويل والمديد والكامل، وفي الطريق نظر إلى المنسرح نظرة عابرة ولم يقف عنده، كانت التفعيلات تقعقع في آذاننا، وكان يقول: الأذن الموسيقية بوابة العروض.
لم نكن نعرف شيئًا عن العروض قبل القحطاني، لقد أيقظ فينا الأذن الموسيقية، وأطلق خيالنا الشاعري، وأوقفنا على أسرار (الدوائر الخليلية) وطرق الفكّ، وعرّفنا المستعمل والمهمل من البحور، وكان يمر على الزحافات والعلل مرور الكريم الخفيف، ويقول: افهموها ثم انسوها!
وفي اختبارات القحطاني الشفوية كنا نأتيه إلى مكتبه في عمادة شؤون الطلاب (كان عميدها) وأقول في نفسي وأنا في الطريق: اللهم باعد بيني وبين المنسرح واكفني شر المضارع والمقتضب، أما زملائي فكان بعضهم يستثقل العروض كما يُستثقل الهمُّ والدَّين، وبعضهم يستطيبه ويلاطفه ويشاغبه !
استطبتُ العروض وأقبلت عليه نفسي، ربما لطريقة أستاذنا القحطاني في تقديمه وتقريبه، وربما لحسِّي الموسيقي الذي تشكّل في طفولتي، فأنا طروب للإيقاع والنغم، وكيف لا أطرب والإبل تطرب لإيقاع التفاعيل في الحداء؟!
ومن أبرز أساتذتنا في قسم اللغة العربية بالجامعة العزيزية الدكتور خليل عمايرة -رحمه الله- وهو أردني، وقد دَرَسنا عليه علم اللغة الحديث (اللسانيات) وأفادنا كثيرًا في نظرية النحو التوليدي عند نعوم تشومسكي، وله محاولات لتقريبها من العربية وإلباسها الثوب والعقال، كما كان يقول، وتناولها في بعض كتبه، ومنها (في نحو اللغة وتراكيبها) و(البنية التحتية بين الجرجاني وتشومسكي) و(النظرية التوليدية التحويلية وأصولها في التراث العربي) وللدكتور خليل عمايرة قدرة عجيبة على التأثير في طلابه، فهو ذو شخصية حميميّة مُرهفة وَدودة مهذّبة، وكان يُقرّب اثنين من طلابه ويخصّهما بعناية فائقة، وهما أحمد سعيد قشاش الغامدي (الدكتور فيما بعد) وكاتب هذه السطور، ولثقته فينا فاجأنا بذكر اسمينا أنا وأحمد قشاش في مقدمة كتابه (آراء في الضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث) في طبعته الأولى التي صادفت تخرجنا في أواخر سنة 1408هـ ،إن ورود أسمائنا في مقدمة كتابٍ لأستاذنا ونحن لم نزل طلابا في البكالوريوس يُعدُّ حدثًا مهما مؤثّرًا في مسيرتنا العلمية التي توشك على الانطلاق، وفي الحقيقة لم يكن الأمر سوى لفتة ذكية تحفيزية من أستاذنا رحمه الله.
وبعد سنوات من تخرجنا والتحاقنا بالجامعة الإسلامية مُعيدَينِ فيها زارنا أستاذنا في المدينة، وقد انتهى عقده مع الجامعة العزيزية، وكان سعيدًا جدًّا بانطلاق رحلتنا الأكاديمية في اللغويات العربية.. رحم الله أستاذنا الدكتور خليل عمايرة فقد عاجلته المنية وهو في عنفوان الرجولة.
في هذه السن كنت أتلمّس طريقي إلى ثانوية الشاطئ الليلية.. لقد بدأت أدير ظهري للقلاب!
ودرسنا النحو في الجامعة عن ثلاثة، وهم: د. عبدالهادي الفضلي ود. طارق نجم عبدالله ود. مصطفى السنجرجي، أما عبدالهادي الفضلي فكان مُتمكّنا من النحو وعلوم التراث، له كتب في النحو والاقراءات وتحقيق التراث، وقد أدركناه في الجامعة وهو في آخر أيامه بالقسم، إذ تقاعد بعد تخرّجنا مباشرة،كان قليل النشاط يميل إلى الصمت، يكتب أبيات الألفيّة على السبّورة ويشرح البيت، على ضوء ما في شرح ابن عقيل، ولا نكاد نعرف عنه شيئا خارج قاعة الدرس، ولم ينخرط في صراع الحداثة، ولم يكن يخرج عن النحو قيد أنملة، يعطي درسه ثم ينصرف،أما د. طارق نجم عبدالله -وهو أستاذ عراقي متخصص في النحو متخرج من الأزهر- فكان فقيرا في التواصل المعرفي، يداري ضعفه في النحو بتصنّع الغلظة والشدة مع طلابه! كان لا يسمح لطالبٍ أن يدخل بعده القاعة أبدا، ولا يقبل عذرًا ولا شفاعة، ولا يسمح بالأسئلة والمناقشة في محاضراته،ولبعض الطلاب قصص طريفة في هذا الأمر، تحوّل بعض إلى لقطات “كاريكاتورية” مضحكة، وأتذكّر أن طالبا رآه سيدخل القاعة فسابقه بالدخول من النافذة فعلق ثوب المسكين وتنكّس على رأسه ونشب، والطلاب يضحكون، قال: ساعدوه، فلما اعتدل الطالب ووقف على قدميه، طرده من القاعة ولم يرحمه!!
كان د. طارق نجم يراقب في الامتحان وحيدا في قاعة كبيرة، ولا تسمع فيها إلا دبيب الصمت، كان يقف في الخلف ثم يباغت الطالب الغشّاش من خلفه، ينسل انسلالا بين الصفون، وكأنه الموت! فإن ضبطه في حالة غش قامت قيامة الطالب، فيُشرّد به من خَلفه من الغشّاشين.
وثالث النحاة د. مصطفى عبدالعزيز السنجرجي، وهو أزهري من مصر، كان أسهلهم أسلوبًا، تجري على لسانه الدعابة المصرية اللطيفة، ولكنّ تأثيره فينا كان محدودًا، له كتاب (المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة) وقد أدركناه قُبيل انتهاء مدة إعارته، مع تقدمه في العمر.
ومن أساتذتي: د. أحمد النعمي –رحمه الله- دَرَسنا عليه مقرّرين: (الأدب الأندلسي) و(نصوص أدبية) وهو أديب ممتع السرد التاريخي والحديث في محاضراته، تجري الدعابة على لسانه جريان الماء، محبوب جدا عند الطلاب، لتواضعه وسماحته وعفويته، حتى لتظن أنّ به غفلةً، وهو من أذكى الناس،كان النعمي زاهدًا ينطوي على حزن دفين، وكان شديد النقد للنساء خاصة، ويُسمّيهنّ (البهائم)! ولا تمرّ محاضرة دون أن يذكر البهائم!! وكنا نتسابق إلى محاضرته عند فتح التسجيل للمحاضرات في مطلع كل فصل دراسي.. ومن أشهر أعماله الأدبية “بأي ذنب قلت”.
يحاضر النعمي في الأدب الأندلسي وتاريخ الأندلس وينتابه كثير من الحماس والنشوة وهو يسرد لنا طرفا من تاريخ عبدالرحمن الداخل، والناصر، وابن تاشفين، ودول الطوائف، وابن زيدون وحبيبته ولادة بنت المستكفي، ويقف طويلا عند مأساة المعتمد بن عباد، ونونية ابن الرندي في رثاء الأندلس،كان النعمي يردّد بتأثّرٍ كبير وبصوت متهدّج نونية ابن الرندي الشهيرة في رثاء الأندلس، التي يقول في مطلعها:
لكلِّ شيءٍ إذا ما تَمَّ نُقصانُ ** فلا يُغرُّ بطيبِ العيشِ إنسانُ
هي الأمورُ كما شاهدتُها دولٌ ** من ســرَّهُ زمنٌ ساءتْه أزمانُ
ومن أساتذتنا آنذاك د. عاصم حمدان الغامدي عرفناه شابا حديث عهد بالتعيين في القسم أستاذا مساعدا في الأدب المملوكي، بعد حصوله على الدكتوراه من جامعة مانشستر ورجوعه من البعثة عام 1406هـ جاءنا الدكتور عاصم حمدان ونحن في المستويات الأخيرة لندرس عليه مادة الأدب المملوكي،كانت محاضرته عصرًا، وهو أديب وكاتب يمتعك بحديثه في محاضرته، وكانت له عناية ظاهرة بكتابة السيرة الأدبية والتأريخ للمدينتين المقدستين، وبخاصة المدينة، فكنا نقرأ مقالاته وسير الأماكن وأشجانها التي عرفها في الزمن الجميل، كحارة المناخة وحارة الأغَوَات وأشجان الشامية،أعارني أستاذي عاصم حمدان رسالته في الدكتوراه (الأدب في المدينة المنورة في القرن الثاني عشر الهجري: أعلامه وموضوعاته وظواهره الفنية) وأعدتها بعد أسبوع، وعنه وعمّا قرأته لعبدالقدوس الأنصاري ومحمد حسين زيدان وعزيز ضياء وحمد الجاسر أخذتُ حبَّ الكتابة في تاريخ المدينة فيما بعد.
ومن أساتذتنا: الدكتور بكري شيخ أمين، من سوريا، كان أستاذا أنيقا مهذبا محبوبا، ذلّل لنا علوم البلاغة، وخفف من جفافها في كتب المتقدمين، كالسكاكي والقزويني، وأعاد عرضها بأسلوبه الخاص، كان بارعا في تقريب علمي المعاني والبيان وتقديمهما في ثوبٍ جديد أنيق بأسلوب عصري،ومنه عرفنا أن البلاغة هي وضع الكلمة المناسبة في مكانها المناسب أو مراعاة مقتضى الحال مع فصاحة اللفظ، كما قال القدامى أو ما يسميه الشيخ عبدالقاهر الجرجاني النظم، وقد أفدنا من الدكتور بكري ومن كتبه (البلاغة في ثوبها الجديد) في أجزائه الثلاثة ودرسنا عليه المستويات الثلاثة من البلاغة، وفي المستوى الأول قرّر علينا الدكتور بكري كتاب الخطيب القزويني (التلخيص في علوم البلاغة) بشرح عبدالرحمن البرقوقي، وإلى اليوم أحتفظ بنسختي وعليها تعليقاتي مع الدكتور بكري.. وأرى أن التلخيص لا يصلح كتابا لمقرر البلاغة في البكالوريوس، فهو وجيز ولا ماء فيه.
وفي المستويين الثاني والثالث رأى أستاذنا أن كتابه (البلاغة في ثوبها الجديد) في جزءيه الثاني والثالث البيان والبديع، هو المرجع الرئيس للمقررين مع مصادر قديمة مساندة، وكنا نرجع بين الحين والحين إلى المفتاح للسكاكي وكتب عبدالعزيز عتيق وبدوي طبانة، ومنها: معجم البلاغة العربية.
ومن أبرز كتب أستاذنا بعد البلاغة في ثوبها الجديد كتابه (الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية) الذي أخرجه في شبابه. ثم رأيت الدكتور بكري بعد خمس وعشرين سنة في عام 1433هـ إذ زارني في مكتبي حين كنت عميدا لكلية اللغة، على هامش مؤتمر اللغة العربية ومواكبة العاصر.
الله على الذوق الرفيع في لبس الشماغ والطاقية يا عبدالرزاق 🙂 صورتي بعد أسبوع من زواجي، في مكة، كان عمري 19.
لا يمكن أن أكتب عن ذكرياتي في قسم اللغة العربية دون أن أقف عند أستاذنا القدير الدكتور عمر الطيب الساسي، فهو من مؤسسي القسم ومن أعمدته الأوائل مع الفضلي والغذامي وسعد مصلوح، والحقيقة أنني تريّثتُ في الحديث عن أستاذنا الساسي؛ لأستجمع ذاكرتي وعدّتي وعتادي وآخذ حيطتي،فأستاذنا الساسي ذو شخصية ذكية لمّاحة مزاجية حادّة كالسيف لكنها سهلة ممتنعة، شخصية عجيبة! وهو ذو ذاكرة قوية وعين راصدة، وويلٌ ثم ويلٌ لطالب ترصده عين الدكتور الساسي في موقف ما وتختزنه ذاكرته التي لا يتسرّب منها شيء؛ سيأخذ الطالب نصيبه وافرًا من التندّر والمداعبة مطلع كل محاضرة،يبشر الطالب المسكين بالتعذيب النفسي، يبشر بمداعبات الساسي وإسقاطاته وسخريته حتى ينتهي الفصل أو العام الدراسي، وكنا نقتصد في كلماتنا ونتحفّظ في تصرفاتنا وحركاتنا ونميل إلى الانكماش والسكون والاختباء خلف أنفسنا كالقنافذ خوفا من أن نُرصد فنكون ضحية التندر حولا كميلا.
وممن رصدته عين الدكتور عمر (جبريل أبو ديّة) في رحلة أبحر حين ألقى جبريل -لسوء حظّه- قصة قصيرة جاء فيها عبارة: (ولمحته بخاصرتها!!) و(الخاصرة) كلمة شريفة رائجة عند الحداثيين في ذلك الوقتن لقد وقع جبريل أبو دية في الفخ (جبريل اليوم مذيع كبير في التلفزيون السعودي) تحية لنجاحاته.
كانت فرصة عظيمة للدكتور عمر لا يمكن أن تفوت، وجبريل محسوب على الحداثيين، وعمر عدوهم اللدود، فعلّق عليها بطريقته المعهودة في السخرية، قال: أها يا جبريل!! لمحتْهُ بخاصرتها؟!! وهل للخاصرة أعين يا جبريل؟ فضحكنا جميعا، وكررها في كل محاضرة.. ولزملائي مواقف كثيرة معه، لا تحصى.
حتى سعيد مصلح السريحي الذي لم يكن معنا في الجامعة آنذاك كان يأخذ نصيبه وافرا من تعليقات الساسي (عن بعدٍ)، قبل التعليم عن بعد؛ لأن السريحي كان من الحداثيين السعوديين المعروفين في تلك الحقبة، وكان الساسي عدوهم اللدود،كان يحلو لأستاذنا الساسي أن يتلاعب باسم سعيد السريحي على طريقة الأضداد اللغوية وتعاقب الحروف، فتراه يحوّل السعيد إلى شقيّ والمصلح إلى مخرّب، فيسميه: شقي مخرّب السريحي.. لكن السريحي حقق نجاحات أدبية لم يحققها أستاذنا الساسي رحمه الله.
بفضل الله ثم بدعاء الوالدين (أقصد الوالد رحمه الله لأن أمي ماتت وأنا في المتوسطة) نجوت من مقصلة عمر الطيب الساسي، لم أقع في فخاخ السخرية العلنية اللعينة، كنت حذرًا جدا لِمَا رأيت من أحوال البائيسين من زملائي! لقد نجوت!
كان أستاذنا القدير الساسي يفعل ذلك تلطيفا لأجواء النقاشات والمحاضرات وكسراً للحواجز بين الأستاذ والطالب، كانت تلك طريقته، فألفنا مداعباته وتعليقاته وتقبّلناها، وهي تصدر منه بعفوية مطلقة؛ لأنه صاحب قلب أبيض، ما في ضميره يخرجه لسانه.. وقد درسنا عليه ثلاثة مقررات وهي (نظرية الأدب) و(الأدب المقارن) و(الأدب السعودي) وأما مقرر (نظرية الأدب) فكان مادة ثقيلة الظل عسرة الهضم لطبيعتها الفلسفية نوعا ما وقد كانت هذه المادة عندي -وربما عند زملائي- كماءِ مرّ على صخرة، فلم يستقر، ولم يبقَ منها شيء في ذاكرتي، وكان الدكتور عمر لا يوليها عناية كافية، أما (الأدب المقارن) فكانت أكثر سلاسة وجمالا وكذلك الأدب السعودي، وله فيه كتاب (الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي) ظهرت طبعته الأولى في سنة 1407 وهي السنة التي درسنا فيها هذا المقرر عنده، فقرر علينا الكتاب، وأفدنا منه على الرغم من وجازته كما يظهر من عنوانه، وهو يشتمل على قدرٍ من التراجم لأدباء سعوديين من أجيال مختلفة، يأتي على بعض نتاجهم الأدبي، مع ذكره بعض المراجع لكل ترجمة.. وللدكتور عمر طريقته في الأسئلة في الاختبارات فهي ذكية وسهلة لكنها ممتنعة، وأحيانا تكون عامّة، وأحيانا مستفزّة، وأذكر أنه في الاختبار لمقرر الأدب السعودي قال لنا، من يريد أن يفتح الكتاب فليفعل، فلما نظرنا في الأسئلة علمنا أنه يتحدانا، فالأسئلة تعتمد على الفهم والتحليل والاستنباط وليست أسئلة معلومات يجدي فيها الغش أو النقل من كتاب.
في المحاضرة الأولى لمقرر (المصادر) عند د.عبدالله المعطاني عام 1405هـ تأخّرتُ لتباعد القاعات، دخلت بُعيد دخول الدكتور، ربما بدقيقة واحدة، طلبتُ الإذن، سمح بالدخول وسألني عن اسمي، ثم قال: هل تحفظ شيئا من الشعر؟ قلت نعم، فأشار إلى السبورة، وقال: اكتب بيتًا،تناولت القلم وأنا أستجدي الذاكرة علّها تسعفني ببيت مناسب، وأقول في نفسي: هذا جزاء من يتأخر، قفز إلى ذهني بيت عابر جدًا لمحمود سامي البارودي، حفظته في ثانوية الشاطئ، وهو قوله : إذا المرءُ لم ينهض لِما فيه مَجدُهُ ** قَضَى وهْوَ كَلٌّ في خُدُورِ العَواتِقِ
علّق الدكتور على البيت، وجعله مدخلا للمحاضرة، وقال لنا: هب أنك لا تعرف قائل البيت، فعليك أن تتأمل ألفاظه ومعانيه وأسلوبه وشاعريته لتحديد عصره وقائله فإنّ لكلّ عصر سمة تميّزه، ولكل شاعر أسلوبًا خاصًّا، وإنّ للتراث الشعري مصادره، غير الدواوين، يمكن الرجوع إليها للوصول إلى البيت،وذكر مصادر مهمة، وكان يرشدنا إلى مجاميع الشعر، كالمفضليات والأصمعيات، وطبقات فحول الشعراء لابن سلام، وأشعار الهذليين للسكري، وجمهرة أشعار العرب للقرشي، وحماسة أبي تمام، والحماسة البصرية لصدر الدين البصري، ومنتهى الطلب في أشعار العرب لابن ميمون.
كان الكتاب المقرر (المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي) لعزّ الدين إسماعيل، وهو كتاب جيّد مناسب للمرحلة الجامعية، انتفعنا به، وأتذكّر أنني اقتنيت أكثر المصادر التي يرشدنا إليها أستاذنا أو يدلنا عليها كتاب عز الدين إسماعيل.
درسنا مقرر (نشأة النحو) على الدكتور حسين الذواد، وهي مادة مهمة وشيّقة، وكان الدكتور حينئذ رئيسًا للقسم، فينشغل به وبمشاكل الصراع بين المحافظين والحداثيين، ومع ذلك أحببنا هذه المادة وتعرّفنا عليها من شرح أستاذنا ومن مصادرها، وتعرفت على جمع من كتب طبقات النحويين، للزبيدي ولغيره،
ومنها المدارس النحوية لشوقي ضيف، وكتاب نشأة النحو لمحمد الطنطاوي وكتاب عبدالعال سالم مكرم: الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي. وبقي صدى هذه المادة عالقا في ذهني سنوات وفي المدينة كتبت بحثي: أصول علم العربية في المدينة المنورة، ونشر في مجلة الجامعة،وكان الدكتور حسين الذواد إداريا حازما وناجحا في رئاسة القسم، قاده إلى برّ الأمان بتعاون الأساتذة الكبار.. ولي مع أستاذنا قصة في بحثي عن أبي الطيب المتنبي الذي كتبته في مقرر الأدب العباسي الثاني عند الدكتور ضيف الله هلال العتيبي، سآتي عليها عند حديثي عن د. ضيف هلال العتيبي.
ودرسنا مقرر (كتاب قديم) على الدكتور أحمد عبدالله السومحي، وهو حضرمي من اليمن الجنوبي، قمة في تعامله ونبله، عمل في القسم في المدة (من 1979-1999م) كان مُغرما بالأديب الحضرمي الكبير علي أحمد باكثير وتناوله في عدة أبحاث: منها (علي أحمد باكثير: حياته وشعره الوطني والإسلامي)
و(الرواية التاريخية في أدب علي أحمد باكثير) ودرسنا عليه نصوصا من أدب الجاحظ في البيان والتبيين والبخلاء، ونصوصا من أمالي القالي، وهو في الجملة هادئ الطباع يميل إلى السكون واحترام طلابه، ولا يملك التحفيز العلمي والتأثير الإيجابي في طلابه.
أما مقرر (الصورة الأدبية) فدرسناه على الدكتور فوزي عيسى، كان من أساتذة الأدب الحديث، معارا للقسم من جامعة الإسكندرية بين عامي (1982-1986م) له كتاب في الشعر السعودي المعاصر، وموسيقى الشعر والدراسات الأندلسية والدراسات النقدية،وعلمت قبل سنوات أنه فاز بجائزة (يوسف بن أحمد كانو) التي تعد من أرفع الجوائز بمملكة البحرين، وكانت الجائزة لكتابه (صورة الآخر في الشعر العرب).
وفي عام 1406هـ درسنا (الأدب الرومنسي) على الدكتور السعيد الورقي (روائي مصري) في عنفوان شبابه، ولكنه كان هادئًا هدوء الشيوخ، يتحدث همسًا ورمسًا، وكان مغرمًا بقصائد الشعراء الرومنسيين الكبار، يروي لنا بعض أشعارهم،من أمثال (جيته) و(لا مارتين) و(ألفرد دو موسيه) و(ألفرد دوفيني) و(فيكتور هوغو) و(شيلي) و(بايرون) و(ووردزورث) و(كلوريدج) ومن العرب خليل مطران، وهو أبو الرومنسية العربية، وأحمد زكي أبو شادي، وعلي محمود طه، وجبران خليل جبران، وإبراهيم ناجي، وغيرهم،وكان السعيد الورقي يسرد لنا تاريخ الأدب الرومانسي الذي يُعدّ أحد أشكال الحركة الرومنتيكية في أوروبا في القرن التاسع عشر، التي نشأت في أحضان الطبيعة، لتثور على العقل وسلطانه وتجعل القلب منبع الإلهام.
ومن رواد هذا الأدب ووردزورث وكوليردج، ألّفا معًا أول كتاب في الأدب الرومانسي والحركة الرومانسية وهو ما يعرف بالأناشيد الغنائية (The Lyrical Ballads) ودرسنا مع أستاذنا قصائد مختارة مترجمة منها قصيدة (الفراشة) لويليام ووردزورث، وقصيدة (أغنية البَحّار العتيق) لكوليردج.
ثم وقفنا طويلا عند جماعة أبولو ومؤسسها في الأدب العربي (أحمد زكي أبو شادي) ونماذج من أشعارهم، وكان الورقي مغرمًا بقصيدة المساء لخليل مطران، ومنها:
يا لَلغـــروبِ وما بهِ من عَبْـرةٍ * للمُســتهامِ وعِبْـــرةٍ للرّائــي
والشّمس في شفقٍ يسيلُ نضارُه * فوقَ العقيقِ على ذُرًا سوداءِ
مَـرَّتْ خِـلالَ غمامتيْن تحـدُّرًا * وتقطَّـرتْ كالدّمعةِ الحمــراءِ
فكأنّ آخـرَ دمعةٍ للكـونِ قد * مُزجَتْ بآخـرِ أدمـعي لرثائي
كان للأدب الرومنسي في شقِّهِ الذاتي وتيّاره الوجداني المتدفق تأثيرٌ كبير في ذائقتي، وله أثر غائر في نفسي، وكنت مغرما بشعر الرومنسيين العرب وشعرهم الوجداني وأخيلتهم وعواطفهم الفردية من أمثال جبران وأبي القاسم الشابّي وعلي محمود طه،وإبراهيم ناجي على وجه الخصوص للنزعة الرومنسية وتدفّقه العاطفي الساحر في دواوينه وراء الغمام والطائر الجريح وفي معبد الليل، وكنت أقف طويلا عند بعض قصائده، كقصائد البُحيرة والخريف والأطلال.. وفي الرواية الرومنسية أولعت بروايات فكتور هوجو على وجه الخصوص: (البؤساء) و(أحدب نوتردام).
وحين أسترجع الأحداث القديمة في طفولتي وفي شبابي وأسترجع تصرفاتي العفوية وإنفعالاتي وذوقي في الفن والجمال والشعر أستطيع القول إني لو كنت شاعرا لكنت ضمن الشعراء الرومنسيين على الأرجح، وقد ألهب في وجداني هذه النزعة أستاذايَ الأديبان د. أحمد النعمي -رحمه الله- ود. السعيد الورقي.
ولم تزل في نفسي بقايا رومنتيكية لا تنمحي تلعب بوجداني وعاطفتي وتجعل من نفسي نفس طفل يهيم ويغني وفجأة ربما تراه يبكي! وما من أحد منا إلا وله حظه من الوجدانية الحالمة أو البائسة، وإن بدا فضًّا غليظ القلب، فكلٌّ منا في داخله طفلٌ يبكي أو طائرٌ يغرد.!
في أيامنا تلك كان مدير الجامعة الدكتور رضا عبيد، وعاصرنا ثلاثة من عمداء كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وهم على التوالي: د. حمد العرينان، ود. سليمان الغنام،
ود. عبدالوهاب بغدادي، وكانت صلتنا بالعمداء ضعيفة جدا، إلا العرينان، بل إننا لم نر بعضهم، ولم نتمكن من دخول مكاتبهم، إطلاقاً،وأقصى مرادنا أن نصل إلى مكتب مدير مكتب العميد، لكن لهذا استثناءات، وأذكر أن الدكتور حمد العرينان استدعاني يوما إلى مكتبه، بتوصية من الدكتور عبدالله المعطاني، كان العميد لطيفا جدا ومتواضعا، وأثنى على قسمنا وجدية طلاب اللغة في العموم، وخصني بشيء من المديح والثناء مما لا أستحقه،وكلّفني بإحصاء ما ورد في بعض المصادر القديمة عن (عوانة بن الحكم الكلبي الكوفي الضرير العلامة الإخباري أحد الفصحاء) لعدم ثقة عميدنا فيما جاء في فهارس بعض المظانّ القديمة التي نقلت روايات عوانة الكلبي، كالطبقات لابن سعد وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد والبداية والنهاية لابن كثير،فعكفت على الكتب الثلاثة في إجازة الصيف وأحصيت روايات عوانة، وجئته في العام الدراسي الجديد بما أحصيته، فشكرني وأهداني ثلاثة كتب تقديرًا وتحفيزًا لي على القراءة والتعلّق بالتراث، ولم تزل الكتب في مكتبتي وهي: البداية والنهاية لابن كثير، وفتوح البلدان للبلاذري، وكتاب المغازي للواقدي،وكان لهذه الكتب أثر في توجيه بعض اهتمامي إلى التاريخ والتراجم، فكانت نواة الركن التاريخي في مكتبتي.. وعلمت فيما بعد أن الدكتور حمدا العرينان ترك العمل الأكاديمي في الجامعة وانتقل إلى العمل مديرا عامّا للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد بين السعودية والبحرين.
وكانت دفعتنا في تلك الحقبة الذهبية في الجامعة مميزة جدا، وقد تفرّقت بزملائي السبل بعد تخرّجهم، شرقوا وغربوا، وحققوا نجاحات تثلج الصدر، ومناصب علمية وإدارية جيدة، وكتبوا أبحاثا ونشروا كتبًا، وشاركوا في المشهد الثقافي والأدبي والأكاديمي، وسأذكر بعضهم هنا، من الذاكرة،وأرجو أن يعذرني من نسيت أن أذكره، وهم: عبدالرحمن بن عيسى الحازمي (الدكتور فيما بعد)، وأحمد سعيد قشاش (الدكتور فيما بعد) والناقد حسين بافقيه باحث بارع، ومحمد هادي مباركي (الدكتور فيما بعد) وناجي بن محمدو حين عبدالجليل (الدكتور فيما بعد) وحمدان الزهراني (الدكتور فيما بعد( وعبدالعزيز عاشور العبيدان (الدكتور فيما بعد) ونصّار بن محمد حميد الدين (الدكتور فيما بعد) والإعلامي عبدالعزيز قزّان والإعلامي جبريل أبو ديّة، وعائض بن سعيد القرني (الدكتور فيما بعد) وعبدالهادي حتاتة الغامدي (الدكتور فيما بعد) وعامر الثبيتي (الدكتور فيما بعد) رحمه الله،ومطيع الله السلمي (الدكتور فيما بعد) ومحمد شتيوي الحبيشي (الدكتور فيما بعد) و يحيى الحكمي (الدكتور فيما بعد) والشاعر مسفر الغامدي، وبخيت سعد الصاعدي، وعبدالله حارق (الدكتور فيما بعد) والمعلق الرياضي الأنيق كمال السوادي، ومحمد الدخيل، وزايد هندي الزهراني (الدكتور فيما بعد).
وحسين الأسمري، وعطية الزهراني، وعبدالمحسن الدوسري، وعبدالعزيز قدسي، وعبدالله آل سلطان، وحميد أحمد عبدالله، وكنز الدولة، وراشد الحسيني من عمان، وهو الآن من أساتذة البلاغة في عمان.. وغيرهم كثر.. فليعذرني من لم أذكر اسمه فالذاكرة خؤون.
في 12/ 1/ 1406هـ كنا في رحلة علمية إلى كلية علوم البحار على ضفاف شرم أبحر، نظّمها القسم وكان فيها: د. حسين الذواد رئيس القسم، ود. عبدالمحسن القحطاني ود. محمد يعقوب تركستاني ود. عبدالله المعطاني ود. بكري شيخ أمين، ود. فوزي عيسى، وعدد من زملائي الطلاب النابهين، ومن زملائي في تلك الرحلة البحرية: عبدالرحمن عيسى الحازمي، وحمدان الزهراني، وحسين بافقيه، وعبدالعزيز قزّان، وعبدالعزيز قدسي، وعائض بن سعيد القرني، وجبريل أبو ديّة، وراشد الحسيني، عماني، وكنز الدولة من السودان، وطالب من كوريا الجنوبية نسيت اسمه،
ركبنا البحر في قارب سريع، ومعنا د. بكري شيخ أمين، كنا ننظر إلى الأفق البعيد، وكأننا نستشرف المستقبل، وفي المساء أقيمت مسابقات ثقافية خفيفة، ومنها مساجلة شعرية نظّمها د. عبدالله المعطاني، وطلب من د. عبدالمحسن القحطاني أن يفتتح المساجلة مع أحد الطلاب وهو عبدالمحسن الدوسري،فقال د. عبدالمحسن القحطاني للطالب: إن غلبتك قالوا: أستاذ غلب تلميذه واستقوى عليه، وإن غلبتني قالوا كبيرة! تلميذ يغلب أستاذه!! فأنا الخسران في الحالتين.. فكانت مساجلة جميلة وممتعة، وكأنهما اتفقا ألا غالب ولا مغلوب.
وبعد المساجلة التي لم يهزم فيها ممثل الطلاب طرح د. المعطاني بعض الأسئلة منها سؤاله عن بيت المعرّي: فمدّتْ إلى مثلِ السَّماءِ رقابَها * وعَبَّتْ قليلاً بينَ نِسْرٍ وفَرْقَدِ ما معناه؟ وكيف تمدُّ الإبلُ رقابَها إلى مثل السماء وتشرب بين نسرٍ وفرقد؟ ومن قائل البيت؟ فأجبتُه؛
وكان الجواب من نصيبي، ويبدو أنّ الدكتور نسي أنه حدثنا عن هذا البيت في مقرر النقد القديم، فنقلت قوله كما هو، فكانت إجابة مباركة إذ جلبت لي جائزة ثمينة، كتابين نفيسين، هما المفضّليات والأصمعيات، بتحقيق العَلمين أحمد شاكر وعبدالسلام هارون، ولم أكن أعرف شيئا عن الكتابين قبل ذاك
والكتابان في مكتبتي إلى اليوم وعليهما تاريخ تلك الرحلة، وتعليق وجيز بخطي، وكان من ثمرات قراءتي فيهما أني أحببت الشعر العربي، وتعلّقت بالتراث ومصادره، وقرأت فيهما قصائد منها دالية الأسود بن يعفر النهشلي، ومطلعها: نامَ الخَلِيُّ وما أُحِسُّ رُقادي * والهمُّ مُحتضِرٌ لَدَيَّ وِسادِي
ومما أتذكره من أحداث تلك الرحلة البحرية أن نقاشا أدبيا نقديا جرى بين د.عبدالحسن القحطاني ود.حسين الذواد وكان موضوعه نرجسية المتنبي وأخلاقه وشاعريته، وهو صدى لما كان يدور من نقاشات بين الشاعر اليمني أحمد بن محمد الشامي والفيلسوف أحمد رحال الشيباني بتوقيعه المستعار: (ذيبان الشمري(،كان حوارا أدبيا ماتعا وساخنا بين الشامي والشيباني على صفحات جريدة المدينة (ملحق الأربعاء) في مقالات عديدة، وقد طال الحوارُ وأمتعَ، وكانت أصداؤه تتردّد في كليتنا وقسمنا على وجه الخصوص، وكنا ننتظره بشغف وترقّب، أسبوعا لذيبان الشمري وأسبوعا للشامي،
وظل الحوار الصحفي محتدمًا بين الأديبين شهورًا، تميل الكفّة تارة إلى الشامي وتارة إلى ذيبان الشمري، ثم جُمعتْ مقالات الشامي وصدرت بعنوان (المتنبي شاعر مكارم الأخلاق). فدار النقاش بين القحطاني والذوّاد، ونحن نتداول إبريق الشاي في جلسة حميميّة في صالون مُطلّ على البحر،ولا أذكر الآن على وجه الدقّة ما الذي دار في النقاش الذي شارك فيه بعض زملائنا، ومنهم حسين بافقيه وجبريل أبو ديّة وكنز الدولة بأسئلة ومداخلات مقتضبة، ولكنني أذكر أن أستاذنا الدكتور القحطاني كان يؤيّد الشامي في دفاعه عن المتنبي وعروبته وأصالته،وأما أستاذنا الذوّاد فكان يميل إلى رأي (ذيبان الشمري) في دعواه بأن المتنبي كان نرجسيا قلقَ الشخصية مضطربا، وأنه كان رقيق الدين منافقا طامعا في إمارة لم يظفر بها في كنف سيف الدولة بحلب فرحل عنه متجها إلى مصر وكافورها الإخشيدي طمعا في الحصول على ولاية أو توزيرٍ يليق به،
فلمّا استيأس الشاعر النرجسي العظيم من كافور دسّسَ له سمومَ الهجاء في معسولات المديح، فخلّف وراءه قصائد من عيون الشعر الخالد.. وتشعّب النقاش بين الأستاذين، فكانت جلسة أدبية ماتعة تكتنفها العفوية والحميمية وروح الشباب.. في صالون كلية علوم البحار المطل على البحر في شرم أبحر.
نعم، والأسماء المستعارة أقنعة كثيفة، ومن اللطائف التي عرفتها فيما بعد أن الشامي والشيباني كانا من جلساء الأديب الشيخ عبدالعزيز التويجري، وكان الشامي لا يعلم أن ذيبان الشمري الذي يحاوره على صفحات الجريدة ويتهم المتنبي بالنرجسية هو جلسيه أحمد الشامي!!
ومن الأسماء المستعارة في أدبنا الحديث: حمزة شحاتة «هول الليل» وعبد الله الفيصل «محروم» وحسين سرحان «ابن البادية» وعبد الله عريف «أبو نظارة» وعبد العزيز الخويطر «حاطب ليل» ومطلق مخلد الذيابي «سمير الوادي» وعلي العمير «صعصعة» وفايز بدر «ابن الحارة» وعبد العزيز المشري «تأبّط خيرا».
ودرسنا (الأدب الحديث) على الدكتور على البطل، رحمه الله، صاحب أسلوب هادئ رزين، يبدأ المحاضرة بأسئلة الطلاب، يسمع السؤال ثم يطرق مليّاً، فيرفع نظره مرة أخرى ويحرك نظارته ويقول: هل لديكم أسئلة أخرى؟ فيسمع المزيد منها، وبعد كل سؤال يسكت سكتةً ويطرق إطراقة، فنظنُّ أنه تجاهل أسئلتنا،ثم يبدأ بالجواب عنها سؤالا سؤالا بطريقة هادئة بطيئة وعميقة، ويشرع بعدها في الدرس، كان من أنصار الحداثة، وله طلاب مريدون، منهم محمد الدَّخِيل، الذي كان بينه وبين أستاذنا صلة ودٍّ علمية وأدبية، وكان يقرأ عليه محاولاته في شعر الحداثة.. مثل: سار الوراء أمامنا !!
ومن أشعار زملائنا الحداثيين التي سُترت ولم تأخذ طريقها إلى النشر: قصائد أمثال (أتدحرج في أحلامي!) و(أمتطي جرادة الليل!) قال لهم الدكتور: أين الأساطير في أشعاركم؟ أما هو فقد درس التفسير الأسطوري دراسة تطبيقية على نصوص من شعر الشاعر السعودي محمد الثبيتي وما تحمله من أبعاد أسطورية،وذات يوم غاب أحد الشعراء من زملائنا، وكان له حضور لطيف وظريف في محاضرات الدكتور علي البطل، فقال الدكتور: أين فلان؟ فأجاب زميلنا (ج د): يتدحرج في أحلامه !!
وكان الدكتور علي البطل واسع الاطلاع والثقافة، وسمعته مرّة يمتدح كتابات الدكتور لطفي عبدالبديع الذي كان معارا لجامعة أم القرى، في تلك الأيام، أيام إشرافه (لطفي) على رسالة الدكتوراه الشهيرة للكاتب سعيد السريحي.
وممن درسنا عليهم في قسمنا الدكتور ضيف الله هلال العتيبي، أُوكل إليه تدريس الأدب العباسي الثاني، كان بعد صلاة الظهر في المبنى الجديد، فربما أراد أن يُلطف أجواء الظهيرة بالشعر وبالحديث عن المتنبي فتزداد الظهيرة حرارة بالمناقشات، وكنا نعرف حبّه العميق وتقديره الشديد لأبي الطيب،فربما سِرنا مع هواه، ولكن ليس دائما، ففي الطلاب (أين كانوا) خبث ومكر، فكان من خبثنا أن نتحرّش بالمتنبي للنيل من شخصيته أو من شعره، فنستفزّ أستاذنا بأسئلتنا الماكرة عن نرجسية المتنبي ونفاقه ومآخذ الخصوم عليه، مما قرأناه في مقالات أحمد الشيباني (ذيبان الشمري) أو المصادر القديمة،فيغضب أستاذنا وينتصر للمتنبي ظالمًا أو مظلومًا، وليس لنا أن نعجب من ذلك، فمن في قلبه ذرّة من حبّ الشعر العربي العالي والعروبة والشجاعة والاعتداد بالذات ليس له إلا أن يعشق شاعر العرب الأكبر المتنبي، وهذه من صفات أستاذنا، وزدْ على ذلك صلته العلمية الوثيقة بأبي الطيب،فأستاذنا ضيف الله العتيبي حاصل على درجة الماجستير في كلية الآداب في جامعة القاهرة عام 1979م في النقد القديم (نقد الحاتمي للمتنبي دراسة وتحليلا) وحاصل على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث من الجامعة نفسها في موضوع: (المتنبي في الدراسات الأدبية الحديثة في مصر) في عام 1983م.
وكان من الحكمة أن نُظهر التقدير للمتنبي والثناء عليه إنسانا وشاعرا في حضرة أستاذنا مجاملة وإرضاء له، وربما كان من الحرص والجدية أنني استثمرت هذا الأمر لصالحي، ولهذا قصة أعتزّ بها.. سأذكرها غدا إن شاء الله.
في نهاية العام الجامعي 1407هـ ذهبت إلى الدكتور ضيف هلال العتيبي في مكتبه، وهو لا يعرفني فقلت له: أستاذي؛ لقد سجّلت عندك مقرّر الأدب العباسي للفصل الأول العام القادم، وأريد أن يكون بحثي عن المتنبي لأجمع مصادر البحث ومراجعه في الإجازة الصيفية، فأطلب الإذن لأبدأ، قال على بركة الله.
فعكفت في الإجازة الصيفية على إعداد بحث موسّع عن المتنبي أسمّيته: (المتنبي ما له وما عليه) رجعت فيه إلى مصادر ومراجع عديدة، قديمة وحديثة، ومنها رسالة الدكتور نفسه، وجدتها في مكتبة الجامعة، فلما بدأ العام الجامعي الجديد كان بحثي في مراحله الأخيرة،ذكّرته في أول محاضرة، قلت: أستاذي أريد أن يكون بحثي في هذا المقرّر بعنوان (المتنبي ما له وما عليه) فقال: هو كذلك، ولم يعلم أنني أوشكت على الانتهاء منه، فمضيت وأتممته، في أنحو 200 صفحة، وجنيت من ورائه فوائد علمية عديدة، ووسّع مداركي في البحث العلمي،وفي منتصف الفصل جئته في مكتبته وبيدي بحثي، نظر فيه وقلّب صفحاته ولشدة إعجابه وتعجّبه تناول ورقة من مكتبه وكتب عليها كلمات ثناء وأحالني إلى رئيس القسم د.حسين الذوّاد ليطلع على هذا البحث،قلّب د. حسين أوراق البحث (كان مكتوبًا بخط يدي لم نكن نطبع أبحاثنا) ثم أخذ يسألني أسئلة عن المتنبي ونسبه وشعره، ومن أبرز من كتب عنه قديما وحديثا؟ أدركتُ من أسئلته ونظراته أنه شكّ في أمر البحث، وأنه ربما كان مسروقا، فلما سمع إجاباتي زال شكّه،
قال لي رئيس القسم: بارك الله فيك يا بنيّ ، وإن شاء الله نراك معيدًا في القسم بعد تخرّجك، وأعطاني بحثي لأعيده للدكتور ضيف الله ليقرأه، فلما انتهى الفصل الدراسي أعاد لي الدكتور ضيف الله البحث وقال لي: يمكنك أن تعيد النظر فيه مستقبلا وتنقّحه وتكمل جوانب النقص فيه وتطبعه إن شئت..
كان جُلّ الثناء من الأستاذين الكريمين للتشجيع والتحفيز، جزاهما الله خيرا، والحقيقة أن البحث ضعيف، لكنه على مستوى الطلاب يعد بحثاً جيّداً، ولم أُعِد النظر فيه؛ لانشغالي بتخصصي في اللغويات، ولكنه لم يزل قابعًا في مكتبتي إلى اليوم شاهدًا على مرحلة انقضت من عمري بحلوها ومرّها.
في تلك الحقبة (النصف الثاني من الثمانينات الميلادية) كنا محظوظين في قسمنا بالزخم الأدبي والحراك النقدي والنشاط العلمي المتوهّج نتيجة التكوّنات والتحوّلات والصراع المحتدم حول الحداثة، وقد وصل الزخم إلى الجامعة وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وبخاصة قسمنا (قسم اللغة العربية)، واستقطبت بعضُ الأقسام في الجامعة شخصياتٍ علميةً ودعتهم إلى إلقاء محاضرات عامة.. ووصل الزخم الأدبي والثقافي إلى نادي جدة الأدبي، فكان موردًا عذبًا لطلاب كلية الآداب بمحاضراته المنبرية ومطبوعاته المهمة.
وأذكر حدثين؛ الأول أن كلية الآداب استقطبت العلامة التركي (فؤاد سزكين) لإلقاء محاضرة عن تجربته في خدمة التراث العربي وتحقيق المخطوطات.. ألقى الدكتور سزكين محاضرته في المبنى القديم لكلية الآداب، وكعادة المتكلم يقلل من شأن نفسه تواضعًا، فذكر أنه شارك في خدمة تراث العربية بقدر طاقته، وبعد فراغه من كلمته دارت تعليقاتٌ ومناقشات، كان أولها مداخلة لأستاذ مصري فاضل من قسم الدراسات الإسلامية (نسيت اسمه الآن مع أن هيئته وصورته باقية في ذاكرتي) وأراد الأستاذ الفاضل أن يعلّق على كلام الدكتور سزكين وأن يثني على جهوده فذكر أنّ للأستاذ سزكين (سهماً) في خدمة التراث..
وكأنّ المداخلة لم تُرض غرور سزكين، فثارت ثائرته، وقال منفعلاً: بل لي (سهمان) في خدمة التراث فعلت وفعلت وفعلت.. وماذا فعلتم؟ (كأنّه يقول في نفسه: أيها العرب!) والحقّ أن الدكتور المداخل لم يخطئ في شيء، لكن يبدو أن سزكين كان ينتظر منه ثناء أكبر مما سمعه في المداخلة.. ولعلّ للمحاضر فؤاد سزكين الحقَّ في انتظار التقدير والثناء الأكمل كفاء ما قدمه للتراث الإسلامي، ويكفيه فخرًا موسوعته (تاريخ التراث العربي) التي طبعت في جامعة الإمام محمد بن سعود.
أما الحدث الثاني فكان لقاؤنا نحن طلاب قسم اللغة العربية بالناقد المصري الكبير الدكتور صلاح فضل بترتيب وتدبير من أستاذنا الدكتور عبدالله الغذامي، على هامش استضافة النادي الأدبي للدكتور صلاح لإلقاء محاضرة بتاريخ 1 رجب 1407هـ بعنوان: (إشكالية المنهج في النقد الحديث)
وفي اليوم التالي دعاه أستاذنا الغذامي ليكون ضيفًا لنا في القاعدة على هامش المحاضرة، ليكون لقاء مفتوحا مع الطلاب، فجمع طلابه في مقرّري (الأسلوب) و(النصوص الأدبية) وكنت أنا في النصوص، وطلب منا أن نثري اللقاء بالأسئلة والحوار،كان لقاء ثريّا جلس فيه الأستاذان متجاورين أمامنا في مدرّج كبير في مبنى كلية الآداب الجديد.. وهذه واحدة من حسنات الدكتور الغذامي الكثيرة ومن مظاهر اهتمامه بطلابه في تلك الحقبة الذهبية،
أما النادي الأدبي بجدة فكان في أيامنا في أوج نشاطه المنبري الأدبي والثقافي، يرأسه الأديب الأستاذ عبدالفتاح أبو مدين، وكانت محاضرات النادي في فندق العطاس بالبغدادية بجدة، ولطلاب قسمنا حضور طيّب للمحاضرات، ومن أبرزهم: حسين بافقيه وعبدالعزيز قزان وأحمد قشاش وجبريل أبو دية،وتأتينا دعوات النادي من وسائل الإعلام ومن بعض أساتذتنا في الجامعة، أعضاء النادي، كالغذامي والقحطاني والمعطاني، فكانت المحاضرات بفندق العطاس زادًا ثقافيًّا أسبوعيًّا يضاف إلى تحصيلنا في الجامعة.. سقى الله تلك الأيام. ومن أمسيات الشعر التي أقامها النادي الأدبي بجدة أمسية صاخبة لا أنساها لأربعة من الشعراء الشباب ممن يتعاطون شعر التفعيلة والشعر الحر، وهم: عبدالله الصيخان، ومحمد جبر الحربي، ومحمد الثبيتي، وأحمد عائل فقيه، فألقى الصيخان قصيدته (فضّة) وألقى بعده محمد جبر الحربي قصيدته (خديجة(،أما محمد الثبيتي فاستهلّ شعره في تلك الأمسية ونحن نراه أول مرّة بقوله: (أَدِرْ مُهجةَ الصُّبحِ.. صُبَّ لنا وطنًا في الكُؤوسْ.. يُدِيرُ الرُّؤُوسْ.. وزِدْنا من الشّاذليّة حتّى تَفِيءَ السّحابهْ.. أَدِرْ مُهجةَ الصُّبح.. واسْفَحْ على قِلَلِ القوم قهوتَك المُرّةَ المُسْتَطابَهْ(،لم يتفق عليها الناس، ولهم فيها مذاهب، ومما قاله منها: (مَرُّوا خِفافًا على الرملِ.. ينتعلون الوَجَى.. أسفرُوا عن وجوهٍ من الآلِ.. واكتحلُوا بالدُّجَى) وقوله: (إنَّا سلكنا الغمامَ وسالتْ بنا الأرضُ) وقوله: (أيا مُورِقًا بالصبايا.. ويا مُترَعًا بلهيب المواويل.. أشعلتَ أغنيةَ العيس فاتّسعَ الحُلم في رِئتيكْ !!)
ومن قصيدة (البابلي) قال الثبيتي في تلك الأمسية:
(مسَّهُ الضُّـرّ.. هذا البعيدُ القريبُ المُسَجَّى بأَجنحةِ الطيرِ.. شَاخَتْ على ساعديهِ الطحالب.. والنملُ يأكلُ أجفانَه.. والذبابْ.. ماتَ ثم أنابْ!!)
لقد كان محمد الثبيتي في تلك الأمسية مثيرا للخيال والأسئلة، تفاعل معه الحضور، وأكرمه مدير الأمسية الدكتور الغذامي بالثناء الأوفر على شاعريته.. وخرجنا من القاعة وأصداء قصيدة التضاريس تقعقع في آذاننا.. أما أنا فاتخذت طريقا بعيدا عن لوثة الحداثة، نجوت بالنحو والتصريف والمعجم.
ومما يميّز جيلي في تلك الحقبة التعطشُ الثقافي والمعرفي والقراءة الواعية والتنقيب عن المصادر الأصيلة، فكنا نعرف العاملين في مكتبات جدة كلها لكثرة ترددنا عليها، رأيت هذا ولمسته لدى كلّ الزملاء تقريبا، لكنّ ثلاثة من زملائي لفتوا نظري بسعة اطلاعهم، وشغفهم بالكتاب والقراءة، وهم: حسين بافقيه وأحمد سعيد قشاش وناجي محمدو عبدالجليل حين، ولكلٍّ منهم شخصيته الثقافية الخاصة..
وفي مكتبتي اليوم مصادر مهمة -لا أدري كيف اهتديت إليها-مقتناة من مكتبات جدة ومؤرخة بأحد السنوات الأربع 1405، 1406، 1407، 1408هـ ولبعضها حكايات ومواقف لا أنساها، منها مخطوط الروحة للجرباذقاني والأغاني للأصفهاني وفهارس لسان العرب التي صنعها أستاذنا الدكتور خليل عمايرة رحمه الله.
وفي شهر صفر من عام 1408هـ حين كنا في السنة الرابعة في دراستنا للبكالوريوس في كلية الآداب بالجامعة العزيزية أخبرنا حسين بافقيه أن جامعة الملك سعود في الرياض ستقيم معرضا للكتاب، سافرنا إلى الرياض أنا وبعض زملائي، ثم رجعنا محمّلين بالكتب في الأدب واللغة ومصادر العربية.
ومما اقتنيته من ذلك المعرض كتاب (السبعة) لابن مجاهد بتحقيق شوقي ضيف، و(التكملة) في التصريف لأبي علي الفارسي بتحقيق حسن الشاذلي فرهود، وكتاب (ابن هشام الأنصاري آثاره ومذهبه النحوي) لعلي فودة نيل، وكتاب (الشعر أو الأبيات الإعراب) لأبي علي الفارسي بتحقيق د. حسن هنداوي. ولكتاب (الشعر) ذاك بتحقيق هنداوي قصة عرفناها فيما بعد على صفحات ملحق التراث، في مقال ناري للدكتور محمود الطناحي، بعنوان (ما يلقى الأكابر من الأصاغر) صبّ فيه الحِمَم على رأس الدكتور حسن هنداوي، والمقال بكامله منشور في صدر تحقيق الطناحي لذاك الكتاب، وأراه قسى عليه،أما أنا فقرأت مقال الطناحي غير مرة، ثم قرأته هذا اليوم في صدر كتاب الشعر، فإن كنت ناصحًا فإني أنصح بقراءته، للوقوف على مكانة الطناحي في تحقيق التراث وعلى لغته التي يكتب بها هذا العَلَم الفذّ، وحسبه أنه تلميذ محمود شاكر، وأقربهم إلى نفسه.. لقد رحل الطناحي وهو في ذروة العطاء.
في مقرّر النقد القديم عند أستاذنا الدكتور عبدالله المعطاني كتبت أول بحث لي في الجامعة وانتشيت به وذقت طعم الإنجاز، كان عنوانه (الوحدة العضوية والموضوعية في القصيدة العربية القديمة: دراسة نقدية) وكتبت فيه نحو 40 صفحة، ووجد البحث استحسانا من أستاذنا المعطاني وأثني عليّ وعلى ما كتبت،ويبدو أنه راعى بدايات الطالب وشغف المعرفة وقدرها وأراد التشجيع والتعضيد، وقد أفادني هذا كثيرا وزرع في نفسي حبّ البحث العلمي في آداب العربية، ثم كتبت بحثا آخر عند د.ضيف الله هلال العتيبي، في مقرر النقد الأدبي الحديث، قبل بحثي عن المتنبي، كان عنوانه: مقياس الوحدة في النقد الأدبي،ولم يزل هذا البحث في مكتبتي أحتفظ به ليكون شاهدا على بداياتي الضعيفة التي لا يميّزها إلا الشغف والطموح. وهنا صورة من البحث، بخطي، وأنا في منتصف مرحلة البكالوريوس.
أما بحثي الرابع فكان في مقرر (دراسات لغويّة في القراءات القرآنية) عند د.محمد يعقوب تركستاني، وهو بحث من نوع مختلف، كان فهرسةً عامة لكتاب تراثي، أراد بها أستاذنا أن يعلّمنا أسرار الفهرسة العلمية، فاختار لي كتابَ (تحبير التيسير) لابن الجزري،وطلب مني فهرسته فهرسةً كاملة شاملة، ففعلت وأنجزت، وتعرفت على أسرار الفهرسة، وقيمتها العلمية، وما يعانيه المفهرسون من مشقة، وتعلمت أنّ الفهرسة مفاتيح الكتب وأنّ الكتاب غير المفهرس كنز بلا مفتاح، وتفتّحت عيناي على مصادر القراءات القرآنية التي لم أكن أعرف عنها شيئا، وهذا بحثي بعد إنجازه، في ١٥٧ صفحة من القطع الكبير، ولا أدري إلى اليوم ما الدرجة التي أخذتها على هذا البحث أو هذه الفهرسة، لكنني حصلت في المقرر على ٩٥٪
وجاء هذا المنشور خلف الغلاف الداخلي لبحثي:
على هوامش المحاضرات كان حديثنا عن جديد الكتب ونوادر الطبعات، وذات يوم ذكر لنا (حسين بافقيه) أنه رأى الطبعة التونسية من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني في مكتبة الشروق بكيلو 3 للوراق الأديب الأستاذ محسن باروم، وهي طبعة نفسية حدّثنا عنها أستاذنا المعطاني،فكنت أتقلقل في محاضرة الأدب الأندلسي عند الدكتور أحمد النعمي –رحمه الله- فلما انتهت المحاضرة أخذت طريقي إلى مكتبة الشروق بصحبة بخيت سعد، فلا تسأل عن فرحتي وسعادتي وأنا أبتاع نسختي من الأغاني في 25 مجلدًا، وهي طبعة نفيسة، وكلما أفتحها اليوم أذكر مكتبة الشروق وحسين بافقيه..
ورأيت في المكتبة نسخة خطية مصورة على هيئتها الأصلية، في مجلدين، كُتب عليها (معجم الروحة في الضاد والظاء للجرباذقاني) قال لي البائع: ثمنها 500 ريال، كان المبلغ كبيرا على ميزانية طالب، ولكنني لم أستطع مقاومة الرغبة في اقتنائها، فدفعت المبلغ بعد تردد،ثم شغلت عنها بالدراسة فلم أقرأها ونسيتها بين كتبي ولم أفطن لأهميتها حتى كان عام 1418هـ كنت حينئذ أبحث عن مخطوط مناسب لأحققه ضمن أبحاث الترقية إلى أستاذ مشارك، فتناولت مخطوطة الروحة، واكتشفت أنها كنز لغوي نفيس جدا،
كان مخطوط الروحة كنزًا لغويًّا في مكتبتي غفلت عنه، إذ كتبها الجرباذقاني بخطة سنة 374هـ فحققت منها باب العين، وأعطيت الباقي بعض طلابي فانتفعوا بها في رسائل ماجستير وأبحاث ترقية، وحلّت فيها بركة، وبعض المخطوطات مباركة.
بعد اجتياز الاختبارات عام 1408هـ وصلت إلى نهاية الرحلة في قسمي الأثير قسم اللغة العربية بكلية الآداب، وتلقّيت آخر نتيجة لآخر مقرر لي في تلك الجامعة بفرحة مشوبة بحزن دفين لا أعرف سببه، وتذكرت قول المتنبي:
خُلِقْتُ أَلوفًا لو رجعتُ إلى الصِّبا ** لفارقتُ شَيبِي مُوجعَ القلبِ باكيا
تخرّجتُ، وحصلتُ على البكالوريوس، كان حلمي أن أكون معيدًا في قسمي في كلية الآداب بجامعتي، فأنا ابن جدة، وتكويني العاطفي جداوي بامتياز، ولو حككت جلدي لظهر تحته شيء من جدة، وأما السنوات الست التي عشتها في ضواحي مكة راعيا للبهم فقد تلاشت من ذاكرتي أو كادت.
كان أساتذتي المؤثرون في قسم اللغة العربية يُلمِّحون إلى فرصة بقائي في القسم ويبشّرون بوظيفة معيد، وربما أوهمت نفسي بذلك (منًى إن تكن حقًّا تكن أحسن المُنى) وكانت خطتي البديلة أن أذهب إلى وزارة المعارف، معلّما للغة العربية، ولم يخطر ببالي شيء غير هذين الاحتمالين،وقفت أمام مفترق طرق، فهربت من الحيرة إلى القاهرة في رحلة استجمام من صديق قريب من نفسي، كنا نتجوّل في شوارعها المفعمة بالحياة والصخب وكان عقلي يتسكّع في أروقة كلية الآداب في جامعتي، لم أكن مرتاحًا، وأنا ذو شخصية قلقة.
فلما رجعت ذهبت إلى القسم فلم أجد أحدًا، سوى السكرتير السوداني الأستاذ بابكر، وهو محبوب الطلاب، قال لي: الأساتذة في إجازة، وسألته عن وظائف معيد، فقال: منذ ثلاث سنوات لم أسمع عن توظيف معيد في قسمنا، فلا تعشّم نفسك بالوهم، هي كالعنقاء المغرب نسمع بها ولا نراها!
كنت قلقا على وظيفة معيد في قسمي الأثير، وكانت خطتي البديلة: الاتجاه إلى وزارة المعارف، لأكون معلما في إحدى مراحل التعليم، ووظيفة المعلم في أيامنا تلك مضمونة، وتقديري يؤهلني، فأنا الأوّل على دفعتي، بل على كلية الآداب كلها،
ولم أكن أعلم أن المدينة المنورة كانت تنتظرني!
قال لي أستاذي الكبير د.محمد يعقوب تركستاني: ما أخبار الوظيفة؟ قلت: أمرها بيد الله. قال: أيمكنك الذهاب إلى الجامعة الإسلامية؟ قلت: في المدينة؟؟ قال: يحتاجون إلى معيدين في قسم اللغويات.. طاف ببالي شريط حياتي في جدة، أحسست بقشعريرة تسري في جسدي.. سكتُّ برهةً، لم يخطر ببالي قط أن أكون من أهل المدينة المنورة، بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته رضي الله عنهم، وأنا لم أر المدينة في حياتي إلا مرتين، ولا أعرف فيها أحدا، وما الذي سأقوله لوالدي الذي يعتمد عليّ كثيرا، فأنا أكبر أخوتي!
تزاحمت مشاعر الرغبة والرهبة الحيرة والشكوك في قلبي، قال أستاذي: أراك تصلح للمدينة وهي تصلح لك، فاذهب ولا تتردّد، فإن وجدتَ راحة في نفسك عند دخولها فهي علامة خير لقادم أيامك، وبلّغْ سلامي لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. علي ناصر فقيهي، واذكر له أنك جئت بتوصية منّي،
تصرّم عام 1408هـ وأظلّنا عام 1409هـ
أصبحتْ جدة والجامعة العزيزية وذاكرتي محطاتٍ عابرةً في حياتي، أصبح ذلك كله خلف ظهري! هأنذا أطرق أبواب المدينة المنورة.. صفحة جديدة ستفتح في حياتي لا يعلم ما فيها من أسرار وأفراح وأتراح إلا الله.
أخذت بوصيّة أستاذي، ومع الفجر اتجهت شمالا أنا وسيارتي الكريسيدا البيضاء كأحلامي، وتأبطتُ ملفّي الأخضر المحشوّ بالأوراق والتزكيات العلمية، وفي الطريق الذي يتوسّد الحرّة توسّدتني الهواجيس والرغبات.. أتشاغل بمذياع السيارة، برنامج (الأرض الطيبّة) الصباحي لعبدالكريم الخطيب يؤنس وحشتي!
سلكت الطريق الجديد الذي لم أسلكه قط، كان جديدا ومريحا للسالكين، رأيت في طريقي لوحات إرشادية كتب فيها: قديد، ثم الظبيّة، ثم وادي ستارة، ثم المواريد، ثم وادي الأكحل، ثم وادي الفرع، ثم اليتمة (أتمة ابن الزبير)، ثم خلص، ثم النقيعة، ثم اللثامة، ثم وادي ريم، ثم العشيرة ثم أبيار الماشي. تراءى لي من بعيد جبلٌ أشهبُ معترض، لا هو حرّة ولا هو من الجبال التي أعرفها، (عرفت اسمه فيما بعد: جبل عَيْر) انعطف الطريق يمينا حين تجاوزته، فإذا المدينة منبسطة أمام نظري ببنيانها الأبيض والخضرة تحيط بها، وإذا منارات المسجد النبوي تشمخ إلى السماء. في تلك اللحظة أحسست بشيء في صدري،شيء مبهم لم أعهده، مزيج من الانشراح والفرح والرهبة، سمعت دقات قلبي التي لم أسمعها طول الطريق، أخذ القلق يسري في عروقي مع الدم، كنت لا أبالي قبل رؤية المدينة، كانت الخطة البديلة (وزارة المعارف) تؤنسني، فلم يعد لهذه الخطة البديلة أي قبول بعد أن رأيت المدينة، القلق يسيطر!!
عند بوابة الجامعة قال لي البوّاب: أنت موظف؟ قلت: لا، أبحثُ عن وظيفة! قال: الله يرزقك، تفضل ادخل.. كانت منشآت الجامعة متواضعة ويجللها السكون والطمأنينة، الطرق والممرات عفوية كأنها شقت طريقها بنفسها، لا تكلّف في شيء، حتى الأشجار أقرب إلى الطبيعة، هنا كل شيء على طبيعته الأولى. كل من أقابله يبادرني بالسلام، الفراشون والطلاب والأساتذة، ذقت السلام وشعرت بأنني في غير عصري، روح إنسانية إسلامية تسري هنا في هذه الجامعة.. لعلها بركة المكان، ولعلها بقايا من إرث الصالحين الذين أداروا هذه الجامعة.. عبدالعزيز بن باز، الألباني، الأمين الشنقيطي، حمّاد الأنصاري..
سألت أحدهم: أين كلية اللغة؟ وفي الكلية سألت آخر: أين مكتب العميد؟ قال العميد (الدكتور الدعجاني) في إجازة وذاك مكتب الوكيل (د.عايض الحارثي) ولكنه في إجازة أيضًا، قلت له: أين مكتب الدكتور علي ناصر فقيهي؟ (وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي) قال: في إدارة الجامعة. اتجهت إلى إدارة الجامعة، قابلني شيخٌ خارجا من المبني، ألقى تحية السلام كالعادة، وخلفه رائحة طيب تتمدد، لم أشم مثله من قبل، التفتُّ إليه أنظر، ثم واصلت طريقي، لوحة مكتوب عليها: مكتب وكيل الجامعة للدراسات العليا، وبجوارها باب مفتوح، تردّدت، ثم دخلت، موظف يلبس غترة ولا يضع عقالا.
قلت للموظف: لو سمحت أين مكتب د. علي ناصر فقيهي؟ قال: ماذا تريد منه؟ قلت أريده؟ قال: أنا علي ناصر، تفضل، خجلت وارتبكت، دخل رجل وصبّ لي قهوة، قال الدكتور علي: أرى في يدك ملفا، هل تبحث عن وظيفة؟ قلت نعم، أنا من طرف د.محمد يعقوب تركستاني.. ابتسم وهشّ وبشّ،قال: إذن تريد وظيفة معيد في اللغة! قلت نعم. تناول الهاتف وأجرى مكالمة، سمعته يقول: (استدعوهم الآن ليقابلوا الطالب فهو قادم من جدة) ثم قال لي: اذهب إلى شعبة الدراسات العليا بجوار كلية الشريعة، وستُجرى لك المقابلة اليوم إن شاء الله، ونتيجة المقابلة غدا، تجدها عندي هنا إن شاء الله.
جلست في أحد المكاتب في شعبة الدراسات العليا بجوار كلية الشريعة أنتظر لجنة المقابلة.. في الممر طالب أفريقي وآخر من آسيا يتحدثان اللغة العربية الفصحى.. استرقتُ السمع: يتدارسان مسألة لغوية من مسائل أصول الفقه، مسألة في حروف الجر، الطالب الأفريقي يسأل الآسيوي: أجابه الطالب الآسيوي: تجد هذه المسألة مفصّلة في الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي.. الجنى الداني، أعرف هذا الكتاب جيدا، وهو في مكتبتي.. وبعد ساعة ونصف رأيت ثلاثة من الأساتذة العرب المتعاقدين، استدعاني أحدهم إلى غرفة مجاورة، لإجراء المقابلة، التوتر والقلق يمتزجان بسكينة المكان!
جلست أمامهم، شيوخ أزهريون يعلو وجوههم الوقار والحكمة (عرفتهم فيما بعد: أحمد عبداللاه هاشم رئيس اللجنة ومعه عبدالعزيز فاخر ومحمد عبدالحميد سعد) رحمهم الله جميعا، سألني أحمد هاشم: أتعرف كتاب سيبويه؟ قلت نعم. قال من حققه؟ قلت: عبدالسلام هارون، قال كم مجلد هو؟
قلت خمسة، وهو عندي، قال: هل له طبعة أخرى؟ قلت: نعم، طبعة بولاق، قال: إذا قال سيبويه: “أخبَرَني الثقة” فمن يقصد؟ قلت يقصد الخليل، قال: غلط، يقصد أبا زيد الأنصاري.. ولم يسألني في النحو، وكان الدكتور أحمد رجلا حازمًا كريمًا، حين رآني مرتبكا قال لي: لا تقلق يكفي أن عندك كتاب سيبويه.
ثم سألني عبدالعزيز فاخر عن ألفية ابن مالك، من شرحها؟ قلت: ابنه بدر الدين وابن هشام وابن عقيل، قال: هل تعرف الرضي الاستراباذي؟ تلكّأت وغمغمت، ثم سألني سؤالا لا أذكره الآن، لكن أذكر أنني قلت في الجواب: الصَّلَمنكي (صحّفته إذ جعلته بالصاد) قال لعلك تريد: الطلمنكي.
وسألني د. محمد عبدالحميد سعد أسئلة في النحو، قال: هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ قلت: قال ابن مالك: (ولا يجوز الابتدا بالنكرهْ * ما لم تفد كعند زيد نمرهْ) ثم التفتَ إلى رئيس اللجنة: فقال الدكتور أحمد هاشم: انتهت المقابلة.. خرجت من عندهم وأنا أتقلقل؛ إذ أخفقت في بعض الإجابات.
وفي صباح الغد: رجعت إلى الدكتور على ناصر فقيهي، كما طلب مني، فأخبرني بأنني اجتزت المقابلة، وكانت وثائقي بيدي فحصها ثم أعطاني خطابًا إلى مدير شؤون الموظفين، وأكملت إجراءات تعييني معيدًا وأخذت خطابًا لفرع الديوان، وفي يوم الثلاثاء أو الأربعاء صدر قرار تعييني معيدًا (سنة تجربيبية(،وبعد الظهر كانت سيارتي الكريسيدا تزفّني زفّا باتجاه جدة، نظرت إلى جبل عير عن يساري فكان مألوفًا هذه المرة، رأيته أجمل مما كان، والحق أنني أرى كل شيء جميلا، حتى الشاحنات، كان الطريق طويلا يتمدّد كأحلامي، وكانت الفرحة تؤانسني، وكنت أفكر في الأسبوع القادم، أسبوع الدوام كما قالوا لي.
مرحلة جديدة بدأت في حياتي.. مرحلة المدينة المنورة والجامعة الإسلامية، أما الجامعة العزيزية (جامعة المؤسس) التي علمتني وأمضيت فيها أحسن سنوات عمري فقد أصبحت من الماضي اليوم، لم تعد من اهتماماتي، وهكذا الإنسان، ابن يومه، أمسه خلف ظهره وغده أمام عينيه.. هكذا الحياة كلها.
اليوم الأول من أيام الماجستير، كان يوم السبت، المحاضرة الأولى، الساعة الثامنة صباحًا، في المبني الذي أجريتُ فيه المقابلة، ليس في القاعة أحد إلا أنا وطالب آخر يلبس غترة بيضاء فوقها عقال، ربما أنا وهو من نلبس العقال، سأتعرّف عليه!
بادرني بالسلام على العادة في هذه الجامعة التي أحببتها من أول نظرة، لا يتركون لك فرصة، دائما يسبقونك بالسلام، قال: أنا عبدالله العتيبي، قلت أهلا وسهلا، وأنا عبدالرزاق الحربي (قلت الحربي ولم أقل الصاعدي) وقبل أن نكمل تعارفنا دخل علينا الأستاذ.. أين رأيت هذا الأستاذ؟
عرفتُهُ! هو الذي أجرى لي المقابلة الأسبوع الفائت، رئيس اللجنة (د.أحمد هاشم) أخبرنا أن المحاضرة في النحو، وأننا سنبدأ بكتاب سيبويه، وأن علينا أن نقتني طبعة عبدالسلام هارون، وأننا سندرس بابين في الكتاب باب الأفعال التي تستعمل وتلغى (ظنّ وأخواتها)، وباب البدل، ثم أبوابا في المقتضب.
بعد المحاضرة أكملنا التعارف أن وزميلي عبدالله العتيبي، قال لي: درست في المعهد المتوسط والمعهد الثانوي في الجامعة ثم في كلية اللغة، وأخبرته بأنني من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.. انقطع حبل التعارف بدخول أستاذ آخر، تأملته فعرفته، كان ممن أجروا لي المقابلة.. أستاذ أزهري سمح الوجه،قال أنا (عبدالعزيز فاخر) وهذه مادة الصرف، وعليكم أن تقتنوا شرح الشافية للرضي، بتحقيق محمد نور الحسن ورفيقيه، وسنبدأ الدراسة في هذا الكتاب من أوله، وحدّثَنا عن الرضي وعن ابن الحاجب وعن الصرف، وأنه شطر العربية، وقال لنا كلاما لم أفهم بعضه، لأنني لم أدرس الصرف قط!!
بعد المحاضرة أكملنا تعارفنا، لم أكن أعلم أن هذا الطالب سيكون (مدير الجامعة فيما بعد) في مرحلة من مراحل العمر، وحتى هو لم يكن يعلم ذلك! انشرحت له نفسي، ودود، نبيه، لبق، يتوقّد ذكاء، وفيه الكثير من شهامة العربي الأصيل، وقبل أن نكمل تعارفنا دخل علينا أستاذ آخر، عرفته أيضا..
كان أستاذنا الثالث: د. محمد عبدالحميد سعد، قال: سندرس الباب الخامس من مغني اللبيب لابن هشام (باب: في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها) وهي عشرة، وحدثنا الأستاذ عن ابن هشام وأنه أنحى من سيبويه، وأننا سنستعين على كتابه هذا بحاشية الشُّمُنّي وحاشية الأمير والدسوقي،بعد المحاضرة الثالثة أكملنا التعارف أنا وزميلي عبدالله العتيبي. ثم قال لي: هل معنا أحد في هذه الشعبة؟ قلت: سمعت أن طالبا آخر سيكون معنا، أعرفه، هو زميلي في جامعة الملك عبدالعزيز، أجرى المقابلة وسيلتحق بنا قريبا، اسمه: عبدالعزيز عاشور.
بعد أسبوعين، علمنا أن المشرف على الشعب (الشيخ عبدالله الغنيمان) ممتعض من فتح شعبة بطالبين اثنين فقط، وعلمنا أيضا أنه يفكر في إغلاقها، لكن شفع لنا وجود اسم زميلنا عبدالعزيز عاشور، فكلما سألونا عنه قلنا: سيحضر الأسبوع القادم، نقول ذلك من (الكيس) فنحن لا نعلم عنه شيئا.
وبعد شهرين يئسَت الجامعة من عبدالعزيز عاشور فقررت استمرار الشعبة بالطالبين أنا وزميلي عبدالله، وكأنها تقول: فيهما بركة. فكنا ندعو لزميلنا عبدالعزيز عاشور ونعترف بفضله في إنقاذ الشعبة، أما هو فلم يحضر لأنه عُيّن مدرسا في وزارة المعارف، ونسي إخبار الجامعة، وكان في نسيانه خيرٌ لنا.
في يوم الأحد جاءنا د. محمد يعقوب تركستاني، في مقرر فقه اللغة، والتركستاني أستاذي في الجامعة العزيزية بجدة، عاد إلى جامعته بعد انتهاء إعارته، كلّفنا بتكليفات متنوعة، ومنها بحث مصغّر للمقرر، كان هو الأستاذ السعودي الوحيد في منهجية الماجستير، انتفعنا منه كما انتفعنا بأساتذتنا.
ثم جاءنا أستاذ أزهري لم أره من قبل، عرّفنا باسمه: (دردير أبو السعود)، وقال: هذا مقرر العروض، وستدرسون البحور والزحافات والعلل من كتاب الخطيب التبريزي، الوافي في العروض والقوافي، كنت مستعدا للعروض، فأنا تلميذ عبدالمحسن القحطاني، فكان المقرر حبيبا إلى نفسي. كانت الدراسة تمضي في طريقها المرسوم، لكنّ مقرر الصرف نغّص أوقاتي، لم أكن أعرف مصطلحاته ولا علله التي يخطفها أستاذنا عبدالعزيز فاخر خطفا، لأنها من مبادئ هذا العلم التي درسها الطالب في المرحلة الجامعية، أما أنا لم أدرس في الصرف شيئا ذا قيمة، وأشرت إلى هذا فيما سبق.
كنت ألجأ إلى زميلي عبدالله العتيبي بعد محاضرات الصرف، وأسأله عن بعض المصطلحات والعلل، وزميلي صرفي بارع، تخصّص في هذا العلم فيما بعد، وحقق كتابين من شروح الشافية الحاجبية، أحدهما لركن الدين الإستراباذي ت715هـ، والآخر للأرّاني الساكناني ت734هـ
لم أفهم مراد ابن الحاجب والشارح الرضي في قولهما: (ويعرف القلب بأصله كناءَ يناءُ مع النأي وبأمثلة اشتقاقه، كالجاهِ والحادي والقِسِيّ، وبصحّته، كأيِسَ، وبقلّة استعماله، كآرام وآدر، وبأداء تركه إلى همزتين عند الخليل نحو جاءٍ أو إلى منع الصرف بغير علة على الأصح نحو أشياء فإنها لفعاء(
وقول ابن الحاجب والشارح الرضي: (… إلا بثبت ومن ثم كان حلتيت فعليلا لا فعليتا وسُحنون وعثنون فُعلولا لا فعلونا، لذلك وعدمه!، وسَحنون إن صح الفتح ففَعلون لا فَعلول كحمدون) قلت في نفسي وأنا أسمع هذا الكلام: (أنا وشْ جابني من جدة لهذه الجامعة)؟
وقول الرضي: (ولا يجوز أن يكون التاءان أصليتين في حلتيت وكذا النونان في سمنان لما سيجيء من أن التضعيف في الرباعي والخماسي لا يكون إلا زائداً إلا أن يُفْصَلَ أحد الحرفين عن الآخر بحرف أصلي كزَلْزَال).. لقد تركت الأدب الرومنسي ووقعت في شباك ابن الحاجب والرضي وعبدالعزيز فاخر!
وعذّبتني كلمة (أشياء) وخلاف الصرفيين فيها، فللكسائي رأي، وللفراء رأي، وللبصريين رأي، قلب وحذف وتقديم وتأخير، وكنت مؤمنًا برأي الكسائي ولكنني أكتم إيماني، لأني غير واثق من صحته! والسلامة في الصمت، وكان زميلي عبدالله يفهم ذلك جيدا، ويجود عليّ ببعض ما يفهمه بعد المحاضرة. وعذّبتني مسائل التمرين، وكان أستاذنا يسألنا سؤالَ معاذ الهراء: كيف تقول من (تؤزّهم أزّا) يا فاعل افعل؟ وصلها بيا فاعل افعل من (وإذا الموءودة سئلت).. ويقول: كيف تبني من رميت على مثال حَمَصِيصة؟ ومن غزوت على مثال أُفُعولة؟ ومن رميت على مثال حَلَكوك؟!
وبعد المحاضرة سألت زميلي عبدالله عن حَمَصيصة وحَلَكوك، فقال: (وش رايك نروح نفطر؟) أدركت أنه ملّ من أسئلتي في مبادئ التصريف، وكأني به يقول في نفسه: (هذا من وين طلع لنا؟) لكنه لم يستطع الفكاك منّي، فأنا نصف القاعة وهو نصفها الآخر !
وفي النصف الثاني من العام الدراسي انقلب الحال، أخذ هذا العِلم (التصريف) يتكشّف لي ويُبرز مفاتنه، لقد وجدت ضالّتي، وأدرك أستاذنا فاخر التحول الظاهر الذي طرأ عليّ، فأصبحت أناقش وأجادل في العويص!
وحين وصلنا مع الرضي إلى اشتقاق (ويلمِّهِ) قال أستاذنا عبدالعزيز فاخر: هذه من الكلمات العويصة، ولأبي علي الفارسي فيها كلام مفصل في الحلبيات، قلت (وكنت قرأتها قبل الدرس وتأملت حالها) ليست عويصة، وتفسير اشتقاقها ظاهر! تعجب أستاذنا من قولي، فقال: غدا تشرحها لنا بالتفصيل، وسنرى !
قال أحسنت، وسأجيزك في التصريف إن شرحت لنا غدا مسألة (تَئِفّة) و(تَلِنّة) ولام (حيّة) قلت: من كتاب الرضي؟ قال: لا، من المسائل المشكلة لأبي علي الفارسي.. عكفت على الكلمات الثلاث في الليل وعرفت أسرارها.. لقد حفّزني أستاذنا شيخ الصرفيين فصار التصريف رفيقي وأنيسي فيما بعد.
كان الرضي نقطة تحول في مساري اللغوي، أحببته وأحببت كتابه شرح الشافية الحاجبية، وأعانني على فهمه أستاذنا الكبير عبدالعزيز فاخر، رحمه الله. وأقول اليوم لطالب العلم: اقتحم العلم الذي يستعصي عليك فهمه، إن كان من اهتماماتك، وسيكون صديقك، لكن عليك أن تصبر قبل أن يفتح لك صدره.
درست في منهجية الماجستير على علماء كبار، وهم: ١- أ.د. أحمد عبداللاه هاشم، رحمه الله. ٢- أ.د. عبدالعزيز فاخر، رحمه الله. ٣- أ.د. عبدالفتاح بحيري، رحمه الله. ٤- أ.د. درديري أبو السعود، رحمه الله. ٥- أ.د. محمد عبدالحميد سعد، رحمه الله ٦- أ.د. أ.د. محمد يعقوب تركستاني، حفظه الله.
وكان اسم أستاذنا أحمد عبداللاه هاشم يثير بعض اللغط، لأن بعضهم يظنه: عبداللاة، بالتاء، وهذا كفر، والصحيح أنه (عبدِالله) بكسر الدال في كل الأحوال وترقيق لام الجلالة، ومنعا للبس بعبدالله كتبوه: (عبداللاه) وينطق: ( عبدِلْ لاهْ) وهذا شائع في بادية الحجاز، ومنها انتقل إلى صعيد مصر.
بعد عناء ومشقة انقضت السنة المنهجية للماجستير وترسّخت أدواتي البحثية في جامعتي الجديدة (الجامعة الإسلامية) التي بَنَتْ الجدار الصلب في تكويني العلمي.. كانت دراستي في جامعتين مختلفتين خيرا لي، وأتيح لي بذلك المزج بين أدبيات البحث اللغوي والأدبي التي تعلمتها في جامعتين مختلفتين.
أدركت أن التصريف عمود اللغة، قال ابن يعيش: (التّصريف من أجلّ العلوم وأشرفها، وأغمض أنواع الأدب وألطفها، حاجة النّحويّ إليه ضروريّة، والمُملق منه مملق من حقيقة العربيّة). وكان ابن عصفور يصفه بأنه شطر العربية وبأنه أشرف الشطرين.
وعرفت فيما بعد أن من أسرار الفقه اللغوي لدى جبّار التصريف أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني التمكّن التام من التصريف، فهو المفتاح السحري لخزائن اللغة.
تشكّلت أدواتي اللغوية، وطغى على فكري التصريف ومعه العروض، وهما الأقرب إلى نفسي، ومن التصريف انزلقتُ إلى المعجم فأحببته، فكانت رسالتي في الدكتوراه في تداخل الأصول وهو موضوع يجمع بين التصريف والمعجم.
وكان علينا بعد المنهجية أن نختار موضوع الرسالة، فاخترت (الإبدال اللغوي) وقُبِل الموضوع، وفي رحلةٍ علمية إلى القاهرة قابلت الدكتور كمال بشر في دار العلوم، وأطلعته على الخطة، فدوّن عليها ملحوظاتٍ مهمةٍ بخطِّ يده، وفي اليوم التالي زرت دار الكتب العلمية فاكتشفت أن الموضوع مدروس!
رجعت إلى جامعتي وأخبرتهم بأن الموضوع مدروس في جامعة مصرية، طلبوا مني التغيير، تقدمت بموضوع (شهاب الدين الخفاجي وجهوده في اللغة) باركه أستاذنا محمد عبدالحميد سعد، وقال: للخفاجي كتب لغوية مهمة: شرح درة الغواص، وشفاء الغليل، وحاشيته الفخمه على البيضاوي (عناية القاضي) وطراز المجالس.
كان مشرفي في الماجستير الدكتور عبدالفتاح بحيري إبراهيم، عالم لغوي أزهري متمكن في النحو والتصريف، كان آية في تواضعه وحسن تعامله، مع عفوية وسماحة نفس نادرة، رحمه الله، حقق في أيام إشرافه على رسالتي التصريحَ للأزهري، في خمسة مجلّدات كبار.
في منهجية الماجستير لم نأخذ العلم كلَّه ولا نصفَه ولا ربعَه ولا عشرَه، وإنما أخذنا الأدبيات العامة والأدوات والمفاتيح، وعرفنا المصادر، وألممنا بالمناهج والأصول والعلل، فسار كلٌّ منها في طريقِه باحثًا عن الإنجاز والبركة.
ترسخت أدواتي في البحث اللغوي الذي كنت أفتقر إليه أيام الجامعة العزيزية، تجاوزت أدوات البحث الأدبي فصار البحث في التصريف والمعاجم وأصول اللغة ودقائقها ضالّتي والتحدي الذي أعشقه، صار هوايتي، وأنا أعشق الصعب، وكتبت فيما بعد (تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم العربي(.
جاءتني فكرة تداخل الأصول من الدكتور سليمان العايد، التقطها من الخصائص لابن جني، وأهداها إليّ في مكالمة هاتفية، عام 1412هـ فوجدت الفكرة قلبا خاليا فتمكنتْ، كانت مفصّلةً لي تفصيلا، كتبت خطتها في شهر، وكان لها قصة في مجلس القسم سأرويها في مذكرات حرف علة إن شاء الله.
لم يكن طريقي في التداخل الصرفي (تداخل الأصول) سهلا، ولم يكن البحث عنه في المصادر ومنها المعاجم ميسورا، فألفاظه تختبئ في الزوايا وتتنكّر حتى لا تكاد تراها، لقد أعياني جمع ألفاظه ومن أجل الإحاطة بها قرأت لسان العرب والقاموس وتاج العروس، قراءة تقميش وتصيّد.
كنت أعمل في تداخل الأصول 15 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، وكنت أؤثر الشهر الكامل على الناقص، وحرمت أسرتي من العيد في جدة، على غير عادتنا منذ مجيئنا إلى المدينة، كنت أسابق الزمن، فسبقته بيوم واحد، قدمت رسالتي جاهزة قبل الموعد الأدنى بيوم، أي في أقل من سنتين بيوم واحد.
في تداخل الأصول تعرّفت على الصرفيين الكبار، سيبويه والفارسي وابن جني، وأدركت أن غيرهم تبع لهم وعيال عليهم، ووقفت على أوهام في التصريف عند معجميين كبار، كالجوهري في الصحاح وابن منظور في اللسان والفيروزي في القاموس والزبيدي في التاج.
حصلت على الدكتوراه في عام 1414هـ من قسم اللغويات في الجامعة الإسلامية، وفي هذا القسم عرفت رجالا من أهل اللغة، وهم طبقتان: طبقة الأساتذة وطبقة الزملاء، وفي كل خير، وربما تحدّثت عن بعضهم إن تيسّر ذلك.
من أعمدة قسم اللغويات: الدكتور علي بن سلطان الحكمي -رحمه الله- عرفته حينما كنت سكرتيرا في قسم اللغويات، كان دمث الخلق حييّا ذكيا، قائدا محنّكا، يميل إلى المرونة والتيسير عند تطبيق النظام، كان يدير القسم بحسّه الدعابي متأدّبا مع الجميع، فكانت أعمال القسم تسير بكل يسر وسهولة.
رافقت الدكتور علي سلطان الحكمي في السفر مرتين أيام الدورات التدريبية التي تقيمها الجامعة الإسلامية لتعليم اللغة العربية خارج المملكة، وعملت معه سكرتيرا للقسم ثلاث سنوات 1410- 1412هـ كان “أبو أنس” أنيسًا سمحًا يحمل في جوانحه روحًا نبيلة ونفسًا زكية.
قُبلت معيدا في قسم اللغويات حين كان الدكتور محمد الدعجاني عميدا، ثم عملت معه سكرتيرا وهو رئيس القسم، في عامي 1413، و1414هـ، والدعجاني مثال للعربي الأصيل النادر، عرفناه في الكلية سخيّ النفس واليد، يضرب بكرمه المثل، وفوق ذلك هو بارع في تحقيق التراث، صارم في منهجه.
بعد حصولي على الدكتوراه جئت للدكتور محمد الدعجاني في مطلع العام الجامعي 1415هـ وقلت له: خدمت القسم سكرتيرا مع أخذ جدولي أكثر من أربع سنوات، معك ومع الدكتور علي سلطان الحكمي، واليوم أرغب في إعفائي من سكرتارية القسم، فوافق بطيب نفس وكرم كما هو معهود منه.
أخذت جدولي في كلية اللغة وكلية الحديث وكلية القرآن، وكان من أبرز طلابي في كلية الحديث: صالح العواجي وعبدالله الفالح ومؤيد الحماد، درّستهم مقرر النحو، ومن أبرزهم طلابي في كلية القرآن: أحمد السديس وأحمد الفريح، درّستهم مقرّر الصرف، وهم اليوم أساتذة كبار يشار إليهم بالبنان.
طلاب الجامعة في تلك الأيام طلاب علم بحقّ، يسألون ويناقشون ويعترضون، مهاراتهم في البحث العلمي جيّدة، كنا نحسب لهم حسابا، ثم انحدر مستوى الطلاب في الأعوام المتأخرة، فأصبحنا نفرح بمن يقول إنه يمتلك كتاب سيبويه أو العين للخليل في مكتبته، ونفرح بمن يقول لنا إنه قرأ سطرين في الخصائص.
وفي ذلك العام 1415هـ راودتني فكرة معجم اللغويين السعوديين وأنا أقرأ صفحات من معجم الأعلام للزركلي، أجود ما كتبه المتأخرون في باب التراجم، وشرعت وراسلت المتخصصين، كانت وسيلتي رسائل البريد في الجامعة، وجاءتني الردود من جامعة أم القرى وجامعة الإمام وجامعة الملك سعود.
جمعت تراجم مهمة في ذلك الوقت، لبعض الأساتذة الكبار، منهم: محمد المفدّى، ومحمد أحمد العمري، وعبدالله الحسيني البركاتي، وغنيم غانم الينبعاوي، وعوض القوزي، ويحيى المعلمي، ومحمد خضر عريف، جميعها بخطوط أيديهم رحمهم الله.. ثم شُغلت عن المعجم بأعمال إدارية في الجامعة وبأبحاث الترقية.
وفي عام 1418هـ دخلت نفق الأعمال الإدارية في الجامعة ولم أخرج منه إلا بالتقاعد، بدأت وكيلا لعمادة مساندة، وانتهيت وكيلا للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وبينهما كنت عميدا للدراسات العليا وعميدا لكلية اللغة العربية.. عملت مع رجال، بدءا بأصغر موظف وانتهاء بمدير الجامعة.
عملت في الجامعة الإسلامية (1409- 1444هـ) مع علماء وفضلاء ونبلاء، مع رجال اقتبست من حكمتهم وتعلّمت من تجاربهم، وأدّيت عملي معهم على وجهٍ رضيت عنه، ولم أقصّر في الجانب الأكاديمي، وهو الأصل في الأستاذ الجامعي، فأنجزت ترقياتي العلمية في أوقاتها، بل قبل أوقاتها.. وذاك فضل الله عليّ.
مبدئي في العمل: الإنجاز الإداري والأكاديمي وتحفيز الطلاب وتوجيههم وحل مشكلاتهم بما تسمح به اللوائح في الجامعة، ومساعدة أصحاب الحوائج منهم قدر طاقتي، ولم أكن متسلّطًا ولا متعاليًا، ولم أقفل باب مكتبي، كان أصغر طالب يمكنه أن يدخل مكتبي في أي وقت شاء.
الإدارات المتعاقبة في الجامعة الإسلامية كانت قريبة جدا من الطلاب والموظفين، ولا أعرف عميدا أو رئيس قسم أقفل بابه ومنع الطلاب، وهذه سمة تمتاز بها الجامعة الإسلامية عن غيرها.
ويستطيع الطلاب مقابلة وكلاء الجامعة في مكاتبهم كل يوم، ويقابلون مدير الجامعة في مكتبه ويمشون معه إلى مسجد الجامعة.. وليس ذلك غريبا على جامعة جلس على كرسيّ القيادة فيها الشيخ عبدالعزيز بن باز، رحمه الله.
يحسب للمجالس العلمية في الجامعة الإسلامية سرعة الإنجاز في إقرار موضوعات الرسائل العلمية، وأزعم أنها من أسرع الجامعات في ذلك. لا أرمي بالقول على عواهنه، بل أقول هذا عن تجربة إذ عشت ذلك بنفسي طالبا ثم عميدا للدراسات العليا عشر سنوات، وأسمع من زملائي في الجامعات الأخرى. لكن المأخذ الأكبر على الأقسام العلمية المتخصصة في اللغة وآدابها (في جميع الجامعات السعودية والعربية أيضا) أنها تفتقر إلى منجزات بحثية كبيرة، تفتقر إلى مشاريع علمية ضخمة، فأي قسم عمره يزيد عن نصف قرن ولم يكن له مشروع علمي كبير منجز فهو قسم نائم، فأيقظوه.
في مجالس الأقسام تتعدّد الآراء، والتعدد نافع، وبه تلقح الأفكار وتثمر وتنضج، وفي كل قسم رأي عاقل متّئد يقابله رأي مندفع، ورأي محافظ يقابله رأي مجدّد، ورأي متحفّظ يقابله رأي جريء، ومن بين الآراء قد يظهر رأي ناشز غايته وضع العصا في العجلة.
مرّ على قسمنا رؤساء تركوا أثرا طيبا في مسيرته، وتنوّعت اجتهاداتهم، وهم ثلاثة أجيال: جيل الكبار، ويمثلهم علي بن سلطان الحكمي، ثم جيل المخضرمين، ويمثّلهم عبدالرحمن بن عيسى الحازمي ثم جيل الشباب، ويمثّلهم بدر بن عايد الكلبي.
ربما أصعب منصب إداري في الجامعة هو منصب رئيس القسم، (أنا لم أجرّبه) يتعامل الرئيس مع أساتذته فيضطر إلى التلطّف والإرضاء، ويتعامل مع زملائه فيحتاج إلى شعرة معاوية، ويتعب في أول الفصل الدراسي ويتعب في آخره، ولا يكاد يسلم من الذمّ.
كان قسم اللغويات في الجامعة الإسلامية من أكثر الأقسام انسجاما مع نفسه وانكفاءً على التخصص، كرّس نهجه الرئيس المحبوب الدكتور علي بن سلطان الحكمي، رحمه الله، وتلك طبيعة أهل اللغة منذ زمن الخليل، يغلب عليهم الهدوء والعقل والحكمة.
تدرك الأقسام النظرية أن الدراسة في مرحلة البكالوريوس وما قبلها هي دراسة تحصيل وتكوين، وأما الدراسة في مرحلتي الماجستير الدكتوراه فليست للتحصيل وحده بل للبحث وصناعة المعرفة، ولذا ينبغي التركيز -في الدكتوراه خاصة- على الموضوعات التي يمكن أن تصنع معرفة.
يحتاج البحث العلمي إلى جُرأة معرفيّة وإقدام على طرح الفرضيات وصلابة في الدفاع عن نتائجها، وهذا ما تفتقده الأبحاث المؤطّرة بالأدبيات الأكاديمية الشكلية في أقسامنا كلها، فهي تفتقر إلى الشجاعة وروح المغامرة البحثية وتكتفي بالشكليات، ثم نطلب من أبحاث الترقية أن تصنع معرفة!
التغريدة الأخيرة في هذه السلسلة: شذرات متفرّقة من حياتي كتبتها في هذه السلسلة التي دامت خمسة أشهر، ولم أقل كل شيء، ولكن حسبي أن تكون نواة لكتاب أفتح فيه نوافذ أوسع للذاكرة.
من حساب الدكتور عبدالرزاق الصاعدي على تويتر منصة X حالياً.
رابط التغريدة مباشرة.
نقلناها لكم في مدونة رشد ،،، شاركونا متعة القراءة في هذه المقامة الرائعة…
 مدونة رشد حول القيادة الإدارية والتجارة وأشياء أخر
مدونة رشد حول القيادة الإدارية والتجارة وأشياء أخر